صوت المسيّرات في رأسي
خلال الحرب، لم أكن أخشى الأصوات كما أخشاها اليوم. اليوم، فرقعة دراجة نارية، أو صوت باب يُغلق بقوّة، يجعل قلبي يرتجف كما لو أنّي شربت مئة كوب قهوة.
خلال الحرب، لم أكن أخشى الأصوات كما أخشاها اليوم. اليوم، فرقعة دراجة نارية، أو صوت باب يُغلق بقوّة، يجعل قلبي يرتجف كما لو أنّي شربت مئة كوب قهوة.
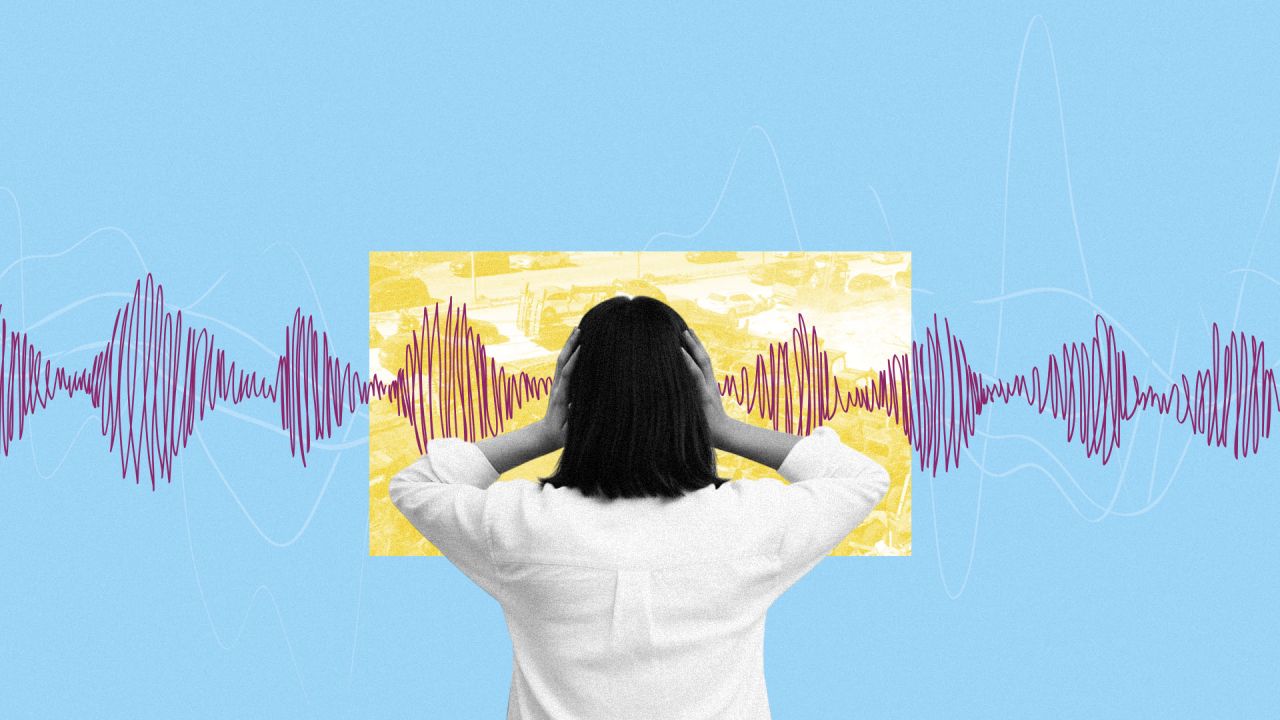
اعذروا شتات أفكاري. في نصّي هذا يكتب الغضب والتوتّر والقلق عنّي. إنها الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، أستيقظ من كابوس يعيدني إلى الحرب. أول ما أسمعه هو صوت الزنّانة، المسيّرة. أدخّن سيجارة. ألعن وأشتم إسرائيل. وأفكّر كم هذا الكوكب ملعون.
يقطع حبل أفكاري صوت يشبه صوت الطيران الحربي. لا أعلم إن كنتُ أتوجّس أم كان فعلًا كذلك، فأتجاهل الأمر. لن أسأل على مجموعات الصحافة على "واتساب"، ولن أوقظ صديقتي لأسألها. أعود إلى الفراش، أغمض عينيّ، وأقول لنفسي انصتي لصوت الفراغ. تمّر درّاجة ناريّة تصدر صوت فرقعة. غبّي من مجموعة أغبياء. ألم يعش هؤلاء الحرب معنا؟ هل أبالغ بقلقي المكبوت المستمّر هذا من الأصوات؟!
خلال الحرب، لم أكن أخشى الأصوات كما أخشاها اليوم. أذكر أنّي كنت أستيقظ على صوت جدار الصوت أنتظر الجدار الثاني ثم أعود للنوم وأغفو وكأن لا شيء حصل، وأقول لنفسي "شو هالبرود!". أمّا اليوم، ففرقعة دراجة نارية، أو صوت باب يُغلق بقوّة، أو أي صوت مرتفع آخر، يجعل قلبي يرتجف كما لو أنّي شربت مئة كوب قهوة، وجُلّ ما يبدر منّي سيل من الشتائم لإسرائيل. شهيق طويل وزفير.
بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، باتت صديقتي التي تقطن في بيروت تعاني من رهاب الأصوات. كانت في بيروت، وعاشت لحظة الانفجار، فباتت الأصوات العالية توقظ فيها هذه الذكرى البشعة. "كميّة التروما بالبلد كمان مش قليلة". أما أنا، فكنت يومذاك نائمة في جنوب لبنان على سريري المطّل على حرش زفتا، ونعمة الهدوء تحرس أحلامي. استيقظت يومها على الصوت، ولكنّي لم أتأثّر كما صديقتي. فقد الجنوب هذه النعمة اليوم. كنت أهرب إليه لأنعم بالهدوء وأرتاح من كتل الاسمنت وأصوات الضجيج. ما زلت إلى اليوم أهرب إليه، ولكن جنوبي الحبيب لم يعد كما كان.
في آخر زيارة لمدينة النبطية مررت بالقرب من بلدة المصيلح في منطقة الزهراني التي استهدف الجيش الإسرائيلي فيها بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر منشأة آليات لبيع الجرافات والحفارات. شاهدت أرزاق الناس المحترقة. باتت كل زيارة للجنوب فيها شهقة تتبعها "الله يلعنهم شو عملوا". لكن الرماد والدمار لن يغطّيا صورة حرش زفتا وطريق النبطية في ذاكرتي.
إنها الساعة الواحدة ظهرًا. صوت ذبابة ضخمة تنخر رأسي. أشعر وكأنها في غرفة الجلوس تكتب معي هذا النص، تراقب قلقي وتسمتع به. أراسل صديقي في الجنوب: "شو الوضع عندكن؟ عنّا مش عم تهدا الـ..." يجيبني: "المهم ما يستهدفوا شي محل". في الجنوب الأمر يتخطّى الصوت. الأمر مصحوب بقلق الاستهداف والقتل. أمّا أنا، هنا، فلا خوف منها. أعيش في منطقة "آمنة". ولكن هل هي آمنة حقًًّا؟
أرى أمامي منشورًا على وسائل التواصل يعرض ردود فعل اللبنانيين على صوت المسيّرات.. الضحك واحد من سبل المقاومة أيضًا
منذ أيّام، مثلًا، كنت أضحكُ على شجار جاري ووالده المسنّ المتكرّر. الشاب الكاره لـ"الحزب" (أي "حزب الله")، الكاره للجنوب برغم أنّه ينحدر من إحدى قراه الحدوديّة. كان يشتم ويلعن ويدعو أن تمحو إسرائيل هذه الفئة من الجنوبيين ومن يؤيدهّا. والأب كان يدافع ويحاول إسكاته بغضب، وأنا أضحك. لكن في الحقيقة أنا أخشى جنون جاري هذا وكرهه لتأييدنا منطق المقاومة وغضبه المستعر دائمًا. من يدري. قد يصّب غضبه يومًا ما عليّ لأن صوت المسيّرة أزعج قيلولته. هل في كلامي مبالغة؟ حسنًا، اعذروني. ولكن هذا البلد فيه من هستيريا الانقسامات ما يرعب حقًّا.
إنها الساعة الرابعة وأربعون دقيقة عصرًا. صوت المسيّرة اختفى والحمدلله. تمّر هليكوبتر للجيش اللبناني يعلو صوتها على صوت ستيرن الماء في الحيّ. تهرول قطتي من الشرفة إلى داخل الشقة وهي تبحلق في السماء. يرّن هاتفي بإشعار. أفتح الرسالة: "المسيرات تحلّق فوق مدرج مطار رفيق الحريري الدولي على علو منخفض". "مُسيّرة إسرائيلية تُحلّق فوق السراي الحكومي". أضحك على التزامن بين كتابة النص والخبر.
لصديقتي الجنوبيّة ثلاثة صبية. باتوا معتادين على صوت المسيّرات. يقول ابن الحادية عشرة بينهم: أرى أنهّا مجرّد طوافة كبيرة. لا أخاف منها، لكنّ صوتها "مش حلو". لكنّ سؤال ابنة صديقتي الأخرى، ابنة الخمس سنوات، آلمني. إذ كّلما سمعت صوت مسيّرة تسأل: هيدي إلنا؟". تسأل لتعرف إن كانت هدفًا، وما إذا كان الخطر قادمًا إليها. الطفلة عاشت رعب قصف الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وباتت أصوات الطائرات كافة مصدر قلق يهدّد طفولتها.
في طفولتنا، كنّا عندما نرى طائرة نقفز فرحين ونشير إلى السماء" "طيارة طيارة". لكن اليوم كل طائرة باتت تهديد.
والد صديقي الستيني الذي عايش حروبًا عدّة مرّت على لبنان بات يعاني اليوم أيضًا من رهاب الأصوات بسبب الحرب الراهنة. لكنّه يمارس عادة غريبة. فكلّما حلّقت المسيّرات، يهرب نحو شجرة ويدخّن سيجارته في ظلّها!
أفهم هذا الشعور. أنا أيضًا أهرب إلى شجر الجنوب وأحنّ لأحراج زفتا. هذا الحنين الهروب أصبحا مختلفين اليوم. بات الحنين أقوى وكذلك الحاجة إلى الهروب. صرنا نزور الجنوب غير آبهين بشيء. لا لشيء سوى لخوفنا من أن تشتّد الحرب من جديد فنُحرم من هذه النعمة.
أتصفّح وسائل التواصل الاجتماعي. أرى أمامي منشورًا يعرض ردود فعل اللبنانيين على صوت المسيّرات بعنوان: "بعد طوشة مبارح أهضم نكت تويتر عن إم كامل ـــ MK (اسم المسيّرة)". الضحك واحد من سبل المقاومة أيضًا.
ها قد عاد صوتها. كنت قد بدأت صباحي بعبارة "خيّ، الحمدلله ما في صوت"، لكنّها عادت. سأنهي كوب القهوة وأضع السماعات في أذنيّ وألوذ بأي أغنية تساعدني على الهروب قليلًا لأبدأ يومي بعيدًا عن مسوخ السماء.
هذا الهروب مؤقت. لأنّنا، في نهاية المطاف، علينا النهوض ومقاومة القلق، والأرق، والمصاعب المزروعة أمامنا. نقاوم عصبيتنا من صوتها. نلعن الاحتلال. ونحنّ للجنوب.