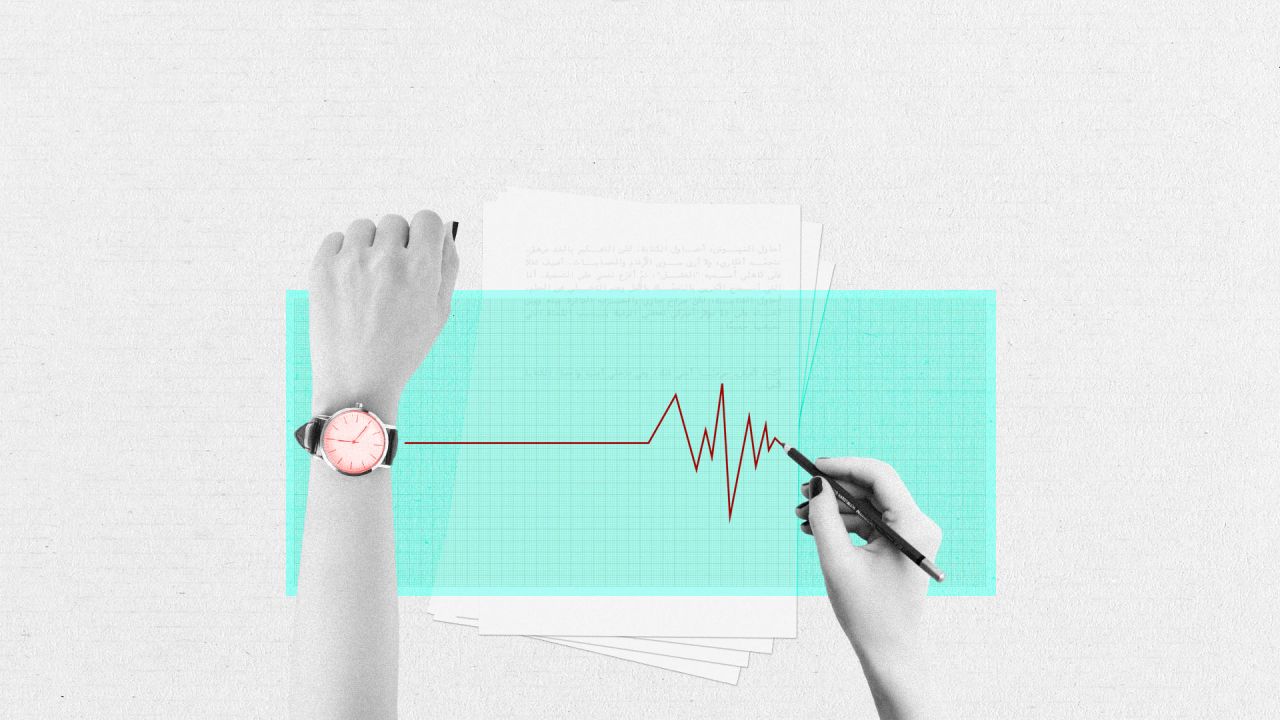
إنها الثانية عشرة والثلث بعد منتصف الليل، أي أنها الدقائق العشرون الأولى في يوم جديد لا أرغب بقدومه. هربًا من هذه الأمنية، لجأتُ إلى الخط الساخن للحياة، مرة أخرى، بعد أكثر من أربع سنوات. لماذا؟ لأنّ البلد دفعني إلى ذلك.
المرة الأولى التي اتصلتُ فيها بالخط الساخن للحياة كانت بعدما تعرّفت إلى صديقتي في بيروت، إثر انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020. كنتُ مثقلة بالحزن. ذاك الحزن الذي زرعه البلد مرفقًا بالوحدة. وكنتُ أحمل وحشي على كتفيّ، وكل من حولي منهك، يختنق. نصحتني صديقتي بالاتصال بالخط الساخن، فكان ملاذي حينها. وها أنا اليوم أعود إليه، لأنّ الخيار الآخر ببساطة غير موجود، ومعظم من حولي منهكون أيضًا.
قبل الاتصال، كنت قد أنهيت للتوّ مشاهدة فيلم The Pursuit of Happiness. شاهدته لأستقي بصيص أمل في عالم تحكمه وحوش ضخمة من إسمنت وحديد، والكثير من الدم. هكذا أنا، عندما أرتطم بالقاع، أحاول النهوض مجددًا، لا لأنّي أملك عزيمة خارقة، بل لأن لا خيار آخر سوى المحاولة مرة أخرى، كما غالبية من حولي.
أفتح حاسوبي لأكتب هذه الكلمات لكي أعيش. أعني هذا حرفيًا، بعيدًا عن المجاز؛ أكتب لأعيش. وأكتب هذه العبارة والخجل من التصريح بها يتملّكني.
أتصفّح هاتفي. أريد اليوم أن أكون رمادية أمام نفسي ـــ لا فرحة ولا حزينة. لا أملك القدرة على رؤية الموت. لكنّ الواقعية من حولي تسلبني الرغبة برؤية الفرح.
ترسل لي صديقتي فيديو عن الاحتفال بالثلاثينيات. احتفال امرأة مستقلة، ناجحة، حرّة من التعلّق برجل، مستمتعة بثمرات تعبها وحدها. لا يضحكني هذا، لا يعزّيني، ولا يبثّ فيّ أي شعور بالأمل أو دافع للاستمرار، بل يدفع بي نحو سوق الأحد في بيروت، السوق الشعبي المكتظ دائمًا يومي السبت والأحد.
كامرأة في هذا البلد، أخشى من عمري، وأخشى أن ينتهي بي المطاف كما الأستاذ الجامعي الذي يبيع الكتب في سوق الأحد
إن كنتَ تبحث عن ماركات بثمن بخس، عليك التوجّه إلى سوق الأحد. وهناك تُباع أيضًا كرامات البشر وسنوات كدحهم. هذا حال الأستاذ الجامعي الذي التقيته، الذي كان يدرّس في جامعات هذا البلد، ويكتب الشعر عنه ويتحدّث عن واقعه. البلد نفسه الذي أجبره على افتتاح بسطة تكوّمت فيها الكتب وغطّاها الغبار، وكانت شاهدة على فشله في الوصول إلى السعادة التي بلغها بطل الفيلم الذي كنت أشاهده، لأنّ بلادنا، برغم حبها للسعادة، تقتلها فينا كل يوم، أو ـــ بالأحرى ـــ لأن الوحش الإسمنتي الضخم يقتل السعادة داخلنا.
لا يرغب الرجل بالحديث عن حاله أمام الكاميرا، بل عن إنجازاته، كي لا يخسر ماء وجهه. أعلم أن المُشاهد لن يتفاعل مع إنجازاته، ولن تتحرّك مشاعر التقدير إلا إذا قصّ عليهم كيف انتهى به الحال من أستاذ جامعي إلى بائع كتب في سوق الأحد.
توقّعَت صديقتي المغتربة أن يُضحكني الفيديو ويمنحني شعورًا بالمتعة، لكنه ذكّرني بعقدة العُمر. كامرأة في هذا البلد، أخشى من عمري، وأخشى أن ينتهي بي المطاف كما الأستاذ الجامعي، علمًا أنّي كنت بالأمس أتحدث مع صديقي عن رغبتي ببيع بعض الكتب من مكتبتي، باستثناء الروايات، لأنّي لا أرغب بأن يقول فراغ الرفوف لي إنّي غير سعيدة، وإنّ الوحش بدأ يقضم منّي.
أحاول إسكات الأصوات السوداوية في رأسي، وأتصل بصديق للحديث عن أي شيء يلهيني عن فواتير الكهرباء، والماء، والإيجار، والمواصلات… أبدأ الحديث بعد الـ"ألو" مباشرة بالقول: "لا تسألني عن حالي، ولا تقل كيفك". ومع ذلك، أجد نفسي واقعة في فخ السؤال، فأتوجّه إليه: "كيفك؟".
"الطَفر" يلاحقنا جميعًا، والبطالة تضع حجارتها على أكتافنا وفي أمعائنا. في هذا السنّ ـــ "الشباب" ـــ نشكو من مشكلات صحية ونفسية تجعلني أقول: يا ليت الشباب ينتهي غدًا إلى الأبد.
أكتب هذه المدونة وأنا أشعر بالخجل. الثلاثينيات في عصرنا مقترنة بالإنجازات، وأنا سرق الاكتئاب مني الكثير. وعندما قمت لمواجهته، سرت وراء حلمي باستكشاف عالم الفن ومحاولة ترك بصمتي فيه، فوجدت نفسي بين عشرات الخريجين نردّد عبارة واحدة: "يا خوفنا نكّش دبّان".
أحاول النهوض، أحاول الكتابة. لكن التفكير بالغد مرهق. تتجمّد أفكاري، ولا أرى سوى الأرقام والحسابات. أضيف ثقلًا على كاهلي أُسميه "الفشل"، ثمّ أقرّع نفسي على التسمية. أنا التي أنصح الآخرين بالتمسّك بالأمل وعدم التخلي عن الحلم. أحاول الكتابة، لكنّ صراخ جاري والحرب الدائرة بينه وبين أخته على 15 دولار أميركي تفقدني الرغبة بسبب اللعنة التي نعيشها جميعًا.
أكتب لأعيش. حرفيًا أعني ذلك. وفي داخلي أمنية واحدة: الكتابة لأحيا.
