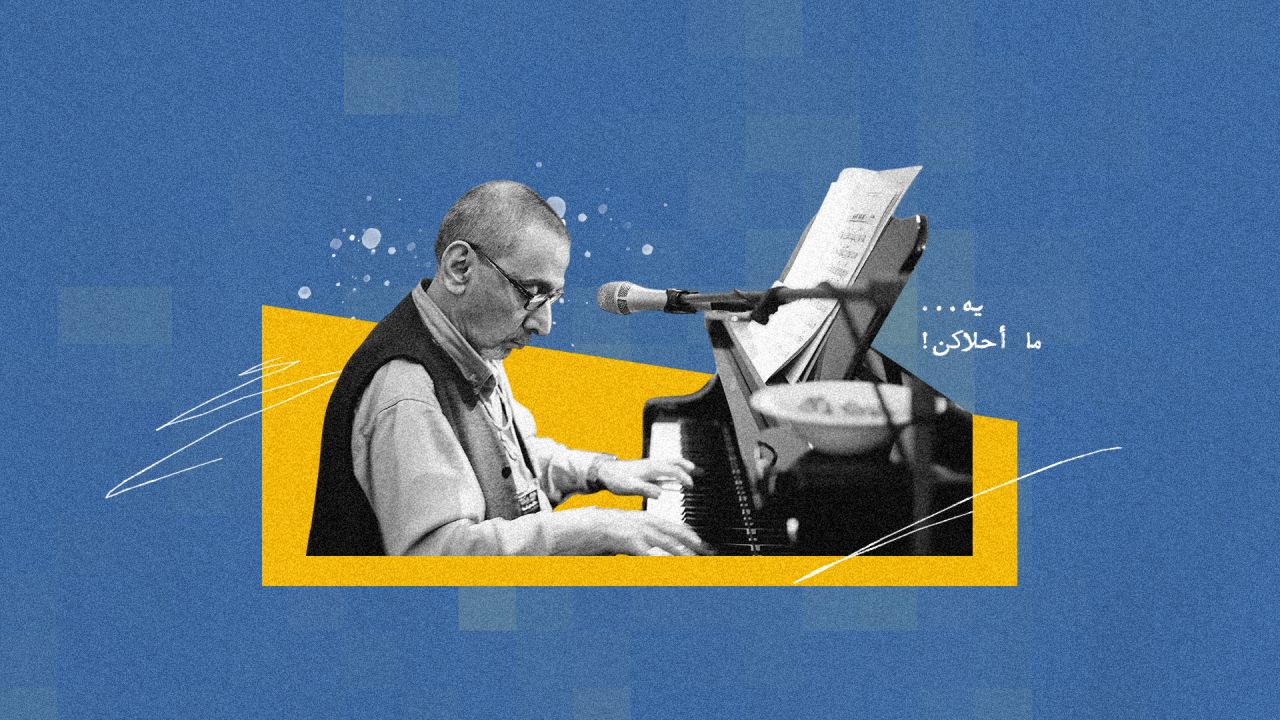
"عبقريّ". أوّل مفردةٍ تخطر في بال غالبيتنا حين يُؤتى على ذكر زياد الرحباني، أمّا أنا فكنت أردّدُ في سرّي أربع توصيفات تختزلُ بعضه؛ "مجنون، حرّ، ثائر، وحالة".
مجنون
كلُّ ما يخصّ زياد خارجٌ عن المألوف. طفولتهُ ومراهقته. حياته العاطفية. تصريحاته. مواقفه السياسيّة. ظهوراته الإعلامية. أغنياتهُ وموسيقاه. جميعها فيها تفرّدٌ وظهرُ حنظلةٍ مُدارٌ للقواعدِ و"الأصول".
السباحة عكس التيّار، في مجتمعاتٍ يذوبُ فيها رأي الفردِ في بدنِ العصبيّات، تحاكي "جنونًا" لجهة ضريبتها.
في مديحِ الجنون يُذكّرنا الكاتبُ الأميركيّ ريتشارد ناش، في رائعته "صانع المطر"، بأنّ "العالمَ بأسرِه يخرج عن طورِه، وبأنّ ما يُمكن أن يُعيده إلى رشده هو مجنون". وهذه واحدةٌ تليق بزياد، فخطابُ الرجل "المجنون" فيه خلاصاتٌ لو طبّقنا نصفها لأعدنا تأهيل جزءٍ يسيرٍ من بلادنا ومجتمعاتنا.
ربّما يكونُ زياد من المجانين النادرين الذين نرغبُ، على الدوام، في معرفة وجهاتِ نظرهِم وآرائهم وكيفَ وبماذا يفكّرون.
حُرّ.
"أنا أفكّر، إذًا أنا موجود". اختزل ديكارت معنى الوجودِ بجدوى الشكّ وطرح الأسئلة.
كان زياد حرًّا على المستويات كلّها. تفلّت من البروتوكولات والقوالبِ الجامدة التي غلّفت أولاد جيله. فكّر وكتب وغنّى وناقشَ في السياسة والأعرافِ والدين والفنون. لم تحاصره أحجية "ما يطلبه الجمهور". تجاهلها ومشى في دربه، وحيدًا، شجاعًا، مختلفًا، متفرّدًا، خاصًّا، حتّى غدت تلك الموهبة العصية على الإدراك هي "ما يطلبهُ الجمهور".
فنّانٌ في مثلِ أثَرهِ وفي مثل إِرثه، كانت ستُفردُ له مسارحٌ البلادِ كلها، وكان سيُكرّم على إبداعه كلما طلعت شمس، لكنّه فشل في تحويلِ نفسه إلى علامة تجارية، والغالبُ أنّه لم يُرد أن يكون كذلك، واكتفى بمنزلة الرّمز، فحظيَ بتشييعٍ شعبيٍّ يشرحُ معنى أن تكون "ابن النّاس"، لا نجمًا ينظرون إليه وكأنّه نصفُ إلهٍ يتمشّى فوق غرائزهم.
لم يستكنْ، ولم ينكفئ إلّا حين هزمه المرض. أمّا قبل، فكانت موسيقاه تصدح في باراتٍ متواضعة على طول شارع الحمرا، يشاركهُ في مِزاجها خمسة موسيقيين، لا أكثر.
فشلَ في أن يكون ثريًّا. فشلَ في أن يكون جزءًا من سيستيم الترفيه الذي يدرّ على أشباه المواهب دخلًا شهريًا يمكنُ له أن يُنقذَ جياع غزّة كلّهم. فشل في أن يكونَ كما أُريد له أن يكون. فشلَ في ألّا يكونَ إلّاه.
في زمن العولمة، حيث تنوسُ القيمُ بين هشّة ومائعة، يصير الفشلُ في الانتماءِ إلى "مَدجنة الميديا" حريّة... وزيادُ، وفق هذا المعنى، كان حرًّا.
ثائر
مُقلقة هذه المفردة. استهلكتها الفضائيات لدرجةِ أنها صارت تُنسبُ إلى إرهابيين ومجرمي حرب، لكنّ العودة إلى جوهر التعريفات تُنصِف وتُنجي.
في السياسة، أراد زياد، ذو الأربعة عشر ربيعًا، أن يلتحق بحزب "الكتائب اللبنانية"، ثمّ تبدّل الهوى مع تبدّل الوعي، ليتحوّل صاحب "فيلم أميركي طويل" إلى واحدٍ من واجهات "الحزب الشيوعي اللبناني".
استطاع زياد أن يتلوّن بين الغضب و"الستاير" والحبّ، لكنّه حافظ على "بساطة المدهشة"، ورتّب مفرداته في سياق يجعلك تستمع وتصفّق، ثمّ تفكّر في الجملة "كيف طلعت معو هي؟"
شيوعيّ، يساريّ، لكنّه وقفَ إلى جانب "المقاومة الإسلامية" في جنوب لبنان وإلى جانب نظيرتها في فلسطين المحتلّة. هذه خلطةٌ تُحيل إلى العنوان الأوّل ربّما.. "مجنون".
لكنّها، في الصُّلبِ، تقولُ إنّ البوصلة واضحة: اليسارُ نصرةً للمظلومين الذين سحقتهُم نيوليبرالية متوحّشة، والوقوف إلى جانب المقاومة نصرةً لأصحاب الأرض الذين يحاول سحقهم كيانٌ وحش (وحش، وحشٌ في تكوينه الأصيل، وليس متوحّشًا).
مرّةً أخرى، الجوهر والبوصلة. هذان ما صانهما زياد، أمّا التفاصيلُ، فلا تخلو من ملاحظةٍ أو غضبٍ أو موقفٍ قاسٍ في حقِّ نظامٍ أو حزبٍ أو تيّار.
في الفنّ، عرّف زياد الثورة على أنّها فعلُ تغييرٍ يبني على ما مضى، لا فعلُ اقتلاعٍ يطيح بتجربةٍ كاملة كي يُعلن وصايته على ما هو آت.
في ميس الريم مثلًا (مسرحية غنائية للأخوين الرحباني / 1975) ألّف زياد فاتحةً تحوّلت، تاليًا، إلى واحدةٍ من كلاسيكياتِ الموسيقى العربية، كما أنّه حضرَ، صوتًا، في العمل إيّاه، عبر حوارية قصيرة مع السيدة فيروز.
كان شريكًا، وجزءًا من مشروعِ عاصي ومنصور، في مرحلة ما، قبل أن يبني هويته الموسيقية والفكرية الخاصة، والتي تقاطعَ بعضها مع إرث والده وعمّه. فأغنيات مثل "بكتب اسمك يا حبيبي" و"أنا عندي حنين" لا تختلفُ، في مزاجها الموسيقي، عن مزاج "بعدك على بالي" و"بكرا لما بيرجعو الخيالة". لكنّ الفنَّ الذي يَبني على فكرٍ هو ما شكّل فرادة زياد الذي قرّر أن يُعيد تشكيل وحلِ لُبنان على حساب أرزهِ وصنّينهِ وشواطئه ودراج بعلبَك، حيث اشتبكَ مع الجانبِ المُحبِط من البلاد، وشرّح لعناتها.
الخروجُ عن عباءة عاصي ومنصور، كان مقامرةً تحتملُ أن تمسخَ صاحبها، إذا هو زلّ، أو أن ترفعهُ إلى مكانةٍ مغايرة، إذا استطاع أن يقدّم قيمة مضافة، وهذا ما نجح فيه زياد.
رفضَ زياد "لبنان الأحلامِ" الذي رسمه كلٌّ من والده وعمِّه في الوعي والوجدان، وانتمى إلى الشارعِ بتناقضاته كلِّها، لكنّه لم ينسف، ولم يتعالَ، ولم يُدِر ظهره للإرث القديم، بل بنى عليه شراكات، بعضها مع السيدة فيروز، وبعضها مع مغنيات ومغنين أخرين.
حالة
قليلون الذين ينطبق عليهم توصيف كهذا. هناك مواهبُ جبّارة، تعومُ على رصيدٍ موسيقي عظيم، لكنّها تظلّ، في التصنيفِ، دون "حالة".
حين نقول "حالة"، فالحديثُ يدورٍ عن شخصٍ صار، رمزًا ونموذجًا، في كليّته، لا في أغنياته وموسيقاه فحسب.
مايكل جاكسون حالة، بوب مارلي حالة، فريد ميركوري حالة، سيّد درويش حالة، وبالقياس، نستطيع أن نقول إنّ "زياد الرحباني، دون شكٍّ أو ريب، حالة".
استطاع زياد أن يتلوّن بين الغضب و"الستاير" والحبّ، لكنّه حافظ، في غالبية نتاجه، على ما يمكن أن نصفه اصطلاحًا بالـ"بساطة المدهشة"، إذ لم يقعّر مفرداته، لكنه رتّبها في سياق يجعلك تستمع، ثم تصفّق، ثمّ تفكّر في الجملة "كيف طلعت معو هي؟".
نزَقهُ، كواحدٍ من تجليّات الحرية، كان سمةً تلذّذ بها محبّوه. قدرته على التعبير عن نفسه كما يشتهي، ضاربًا عرضَ الحائطِ بـ"إيتيكيت الفنّان"، قرّبتنا منه. حريّتهُ الحلوة، التي لا تبدي بذاءة اتجاه ثوابتِ الآخرين، جعلتنا ننتشي بخطابه. فكرهُ الذي يُحاكي الواقع حدّ الوثيقة، جعله جزءًا من يومياتنا. كان نخبويًا بسيطًا، أو بسيطًا نخبويًا. الوجهان يجوزان ربّما.
هناكَ شريحةٌ تحزنُ على رحيله بصورة تفوق سواها. شريحةٌ تشعرُ أنّ مشروعَ نهضةِ البلاد في خطر، وأنّ مفردات الوعي في خطر، وأنّ عمومَ ما حلمنا به من كرامةٍ وشرفٍ وتنويرٍ في خطر، وأنّ فكرة "فلسطين الحرة" في خطر.
أمثالنا، مُنوا بخسائر فادحةٍ في العقدِ الأخير، وبتنا أكثر حساسيةً لوداع رمزٍ لطالما اعتبرناه انعكاسًا للفنّ وللفكرِ وللمقاومة التي تشبّثنا بمعناها وجدواها لا بأفرادها. لذا، نرثي زياد على هذا النحو، ونبكيه في النص وفي المجالسِ وفي كل مناسبةٍ متاحة.
"مجنون، حرّ، ثائرٌ، وحالة"..
أمّا بعد:
عبقريّ... بالضرورة.
