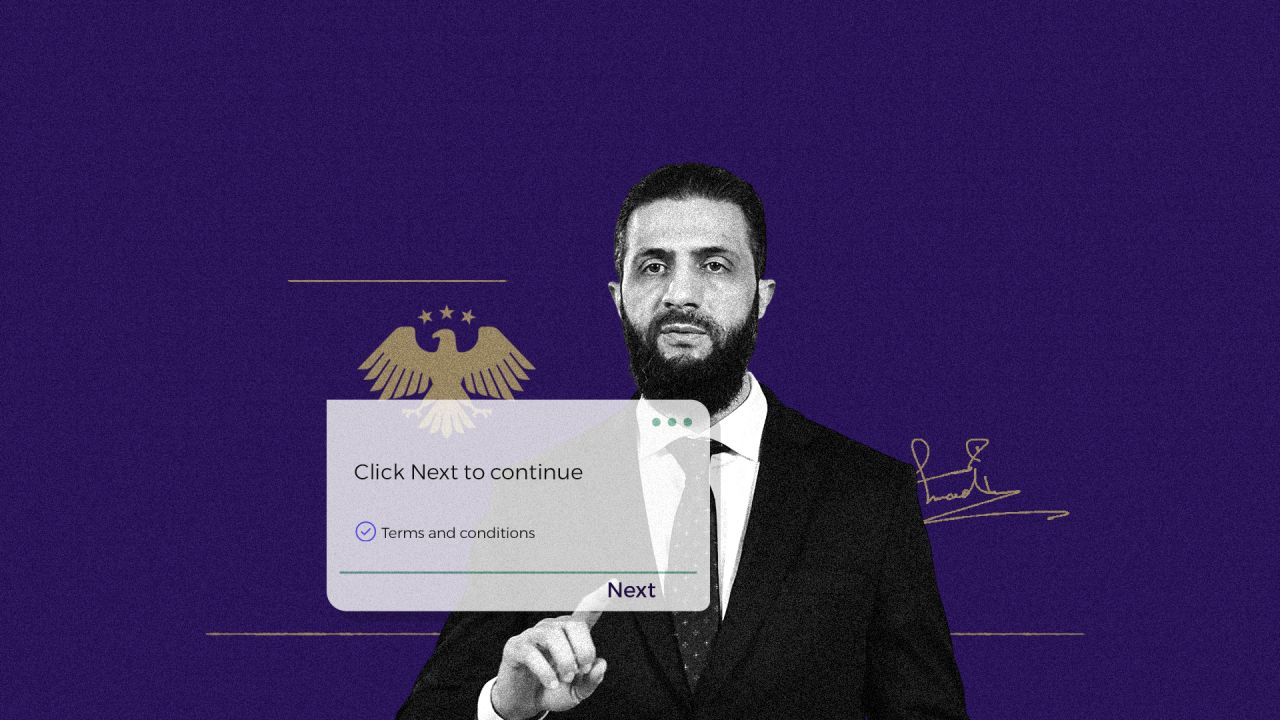لم تعد بعض السلطات في المشهد الإقليمي تُقاس بقدرتها على بناء السيادة أو تمثيل الإرادة الجمعية، بل بمدى قابليتها للتموضع في منظومات خارجة عن شرطها الوطني، وبكفاءتها في تأدية أدوار جزئية ضمن ترتيبات لا تنتجها، ولا تملك أدوات تعديلها. وفي مثل هذه السياقات، تفقد الدولة معناها ككيان سياسي سيّادي، وتتحوّل إلى مساحة يُعاد رسم حدودها من خارجها، في مقابل قدرة محدودة على إنتاج الفعل.
هذه الصورة تنطبق بدقة على السلطة الانتقالية في سوريا، التي تمارس حضورها السياسي من خارج أي مُرتكز تمثيلي داخلي. بُنيتها التكوينية لا تنهض على تفويض شعبي، ولا تتصل بعقد اجتماعي ووطني سيادي، بل تتحرك ضمن مجال مفروض وظيفيًا، تُعاد صياغته بحسب أولويات الفاعلين الإقليميين والدوليين، لإعادة هندسة موقع سوريا في النظام الشرق ــــ أوسطي، عبر آليات تطبيعية مع إسرائيل. وهي في ذلك لا تعبّر عن انتقال نحو الدولة، بل تستقر في منطقة رمادية بين التسيير والتوظيف، حيث تُقاس جدواها بقدرتها على تأدية ما يُطلب منها.
هذا النمط من السلطة يمثل شكلًا من أشكال "الشرعية المؤجلة"، التي لا تنبع من الداخل ولا تُستمد فيها السلطة من عقد اجتماعي قائم، بل تُبنى خارجيًا على قاعدة التوظيف السياسي. ومن هذا الموقع الهش، تندفع السلطة الانتقالية السورية إلى إعادة تعريف دورها عبر التطبيع مع إسرائيل، بوصفه آلية للبقاء السياسي ضمن نظام إقليمي تُعاد هندسته. وعليه، فإن السؤال الجوهري لم يعد متعلقًا بمسار التأسيس والانتقال للسلطة، بل بمصير الدور ذاته؛ فهل نحن إزاء سلطة تعيد إطلاق مشروع الدولة، أم أمام جهاز مرحلي مُصمَّم لتأدية مهمة محددة ثم الانكفاء أو التلاشي؟
تكمن المفارقة الجذرية في أن السلطة الانتقالية التي أُنشئت بحجة إنقاذ الدولة، تُدفع اليوم إلى اتخاذ قرارات كبرى باسمها، من دون أن تمتلك مقومات وجودها. فبينما تُفترض كمرحلة لإعادة التأسيس، يُراد لها أن تُجسّد لحظة التنازل المُقونن.
سلطة انتقالية أم وكالة مؤقتة؟
لا يمكن التعامل مع انخراط السلطة الانتقالية السورية في مسار تفاوضي حول التطبيع مع إسرائيل بوصفه خيارًا سياديًا، ولا حتى كموقف سياسي نابع من تقدير للمصالح الوطنية. فهذه السلطة تفتقر إلى المقومات الأولية التي تؤهلها لخوض مفاوضات بهذا المستوى من التعقيد. إنها لا تملك بنية تفاوض، ولا تسيطر على فضائها الداخلي، ولم تنتج حتى اللحظة تصورًا متماسكًا للدولة بوصفها إطارًا سياديًا.
إن أكثر ما يُثير الريبة في هذا المسار، هو اختيار سلطة انتقالية مهزوزة وهشة لفتح ملف بحجم التطبيع مع كيان محتل. فـ "التطبيع"، حين يصدر عن سلطة فاقدة للحد الأدنى من الشرعية الوطنية، يُعد انزلاقًا إلى تسوية من طرف واحد، يُبَرّأ فيها الكيان ويُمنَح فيها صك الاعتراف بواقع مفروض. وليس من تفسير عقلاني لانخراطٍ كهذا سوى أنه محاولة لتأمين موطئ قدم سياسي للسلطة الانتقالية في نظام إقليمي.
هل تمثّل هذه السلطة انتقالًا وظيفيًا نحو شرق أوسط ما بعد قومي، تُحدد فيه الدول من خلال قابليتها للدمج ضمن منظومات أمن إقليمية يقودها الخارج؟
إن الدخول في ترتيبات سلام إقليمي، في ظل هذا الفراغ البنيوي، لا ينهض على إرادة وطنية، بل يُستمد من منطق فوقي يحدّد للأطراف أدوارها وفقًا لحاجات النظام الإقليمي. وما يُسمّى بـ"الواقعية" هنا لا يُشير إلى تقدير موضوعي للظرف السياسي، بقدر ما يشير إلى انضباط وظيفي تحت سقف خارجي، يجعل من التوقيع على الاتفاقات مجرّد إعلان عن الامتثال، وليس حتى عن الرغبة في السلام.
بحسب أطروحات ماكس فيبر، فإن الدولة تُبنى على احتكار العنف الشرعي ضمن حدودها، لكنها أيضًا تحتكر التمثيل السياسي. غير أن السلطة الانتقالية في سوريا لا تحتكر شيئًا من ذلك؛ لا السيادة، ولا أدوات العنف، ولا حتى التمثيل الرمزي. وهذا يجعلها أقرب إلى ما يُعرف في النظرية السياسية بـ"السلطة الوظيفية"، أي السلطة التي تُنشأ لغرض محدد، وتنتهي بانتهاء المهمة.
وفي هذا السياق، تُطرح محاولات السلطة الانتقالية للانخراط في ترتيبات إقليمية، كجزء من مشروع أكبر لإعادة تموضع النظام الإقليمي بعد تآكل مركزية الدولة الوطنية، وظهور "نظام ما بعد الدولة"، حيث تُدار السيادة عبر شبكات متعددة الفاعلين؛ دول، وشركات، ومنظمات فوق وطنية.
وهنا يُصبح من الممكن استدعاء مفهوم "الدولة كأثر" كما نظّر له تيموثي ميتشل، حيث لا تعود الدولة كيانًا ماديًا مستقلًا، بل كنتيجة لإنتاج خطاب وممارسات تُوهم بوجودها. كما تُمثّل الحالة السورية نموذجًا لما تُسمّيه الأدبيات "السيادة المفككة"، أي السيادة التي تُجزّأ بين أطراف متعددة، وتُمارس خارج مؤسسات الدولة، أو تُدار عبر وكلاء يخضعون لإملاءات خارجية.
هذا يضعنا أمام سؤال مفصلي؛ فهل هذه السلطة تمثّل انتقالًا وظيفيًا نحو شرق أوسط ما بعد قومي، تُحدد فيه الدول من خلال قابليتها للدمج ضمن منظومات أمن إقليمية يقودها الخارج؟
من التابلاين إلى إبراهام.. مفارقات اللحظة
في عام 1949، لم يمضِ على الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم (29 آذار/مارس 1949) سوى أشهر قليلة، حتى وافق على مدّ خط أنابيب التابلاين الذي مرّ في الأراضي السورية كجزء من مشروع نفطي إقليمي تقوده الولايات المتحدة. لم يكن المشروع حينها سوى أولى علامات تحويل السلطة السياسية في سوريا إلى أداة وظيفية ضمن النظام الإقليمي الناشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لم يُكتب للزعيم البقاء طويلًا، فالسقوط أتى بالسرعة نفسها التي جاء بها، وكان السبب في الحالتين واحدًا؛ أداء وظيفة إقليمية أكبر من قدرة السلطة على تحمل تبعاتها.
اليوم، يبدو أن السلطة الانتقالية في سوريا، برغم اختلاف الظروف والفاعلين والسياقات، تُدفع دفعًا لأداء وظيفة مشابهة، ولكن تحت يافطة جديدة أكثر خداعًا متمثلة بـ "السلام الاستراتيجي". فهل نحن فعلًا أمام لحظة إعادة تشكيل جديدة للدور السوري في الإقليم، أم أن ما يجري ليس إلا محاولة لتسييل موقع سوريا الجغرافي مقابل شرعية موهومة مؤقتة تُمنح من الخارج.
إن رفض التطبيع هنا يجب أن يُفهم بوصفه دفاعًا معرفيًا عن مفهوم الدولة ذاتها
هذه المقارنة التاريخية، برغم تغيّر السياقات، تكشف بنية متكررة في نمط السلطات التي يُعاد إنتاجها وظيفيًا. فكما أُسقِط حسني الزعيم بعد أشهر من توقيعه اتفاقًا لم يكن مدعومًا بإجماع داخلي، تواجه السلطة الانتقالية السورية اليوم خطر أن تتحول إلى ما يشبه "السلطة الفلسطينية" التي وُلدت باتفاق مرحلي عام 1994، لكنها بقيت محصورة في وظيفة إدارية دون أدوات سيادية حقيقية. وكلا الحالتين تُظهران خطورة أن يُلقى على سلطة غير تمثيلية عبء توقيع اتفاقات سيادية في لحظات فراغ سياسي حاد.
ويمكن أيضًا أن نجد تشابهًا بنيويًا مع تجربة "مجلس الحكم العراقي" الذي أنشأته الإدارة الأميركية بعد الاحتلال عام 2003، ككيان انتقالي فاقد للشرعية الشعبية، ومُحاط بشبكة وظيفية من الخارج، أدّت إلى إطالة أمد الفراغ السيادي. وهو ما يُنذر بأن أي دور تفاوضي في ظل هذه السلطة، سيعيد إنتاج النموذج العراقي.
فـ"الوظيفة"، بحسب جيمس سكوت في كتابه "رؤية الدولة"، تبدأ عندما تُعاد صياغة النخب الحاكمة لتُلائم منطق السوق الجيوسياسي، وليس منطق الأمة. واليوم، لا يبدو أن السلطة الانتقالية السورية تتحرك انطلاقًا من رؤية وطنية لإعادة بناء الدولة، بل من موقع "الملحق الوظيفي" ضمن منظومة سلام إقليمي قائم على موازين قوى مختلة، تجعل من التطبيع أداة تأهيل للسلطة.
تُظهر الأدبيات الحديثة في النظرية ما بعد الكولونيالية، كما في أعمال إدوارد سعيد، أن الهيمنة لا تُمارس بالقوة فقط، بل عبر إعادة تعريف ما هو مقبول ومُمكن ومشروع. ومن هذا المنظور، فإن مشروع التطبيع الذي يُعرض اليوم على دمشق الانتقالية ليس خيارًا سياديًا، بل هو إملاء سيادي، تُفرض فيه شروط التفاوض من أعلى، وسيتم تسويقه داخليًا على أنه انتصار واقعي، أو عقلانية استراتيجية.
أخطر ما يمكن أن تُنتجه لحظة كهذه هو استبدال فكرة "الحق" بفكرة "التكليف"، أي تحويل السلطة من ممثّلة لإرادة الشعب إلى منفّذة لمشروع هندسي خارجي. فحين يُعاد تعريف السيادة من قبل قوى الخارج، ويتم تقليص سوريا إلى موقع جغرافي قابل للاستثمار السياسي، نكون قد انتقلنا من الدولة كتصوّر إلى الدولة كامتياز يُمنح مقابل التنازل عن الحق.
إن توقيع اتفاق "سلام/تطبيع" مع قوة احتلال لا يُعيد فقط تعريف موقع سوريا السياسي، وإنما يطرح سؤالًا وجوديًا حول صورة الذات الوطنية بعد الثورة والحرب. فهل ما يزال يُمكن تعريف سوريا ككيان سياسي مستقل إذا تم تمرير سياسات التطبيع من قبل سلطة انتقالية فاقدة للتمثيل؟ وما أثر ذلك على الذاكرة الجمعية، وعلى وعي السوريين بأنفسهم كوطن له حدود، وموقف، وهوية سيادية؟ إنّ ما قد يُقدَّم اليوم على أنه تسوية، هو في جوهره تفكيك ناعم لمعنى السيادة، وإعادة هندسة للوعي الوطني تحت سقف هندسي خارجي.
وعليه، فإن رفض التطبيع هنا يجب أن يُفهم بوصفه دفاعًا معرفيًا عن مفهوم الدولة ذاتها. ذلك أن الدولة في لحظات التأسيس أو الانتقال، لا تُقاس بقدرتها على توقيع الاتفاقات، بل بمدى قدرتها على تمثيل الإرادة الجمعية وصون المعايير المؤسسة للسيادة. وكل انخراط في تسويات بهذا المستوى، دون امتلاك هذا الشرط التمثيلي، لا يُنتج سلامًا، وإنما يُعيد تعريف الدولة كمجرّد هيكل إداري قابل للتأجير السياسي.
وهذا يعيدنا إلى سؤال الدولة كمفهوم. فهل ما نملكه الآن هو دولة في طور التحوّل، أم سلطة في طور التفكك؟ وهل نعيش انزلاقًا تدريجيًا نحو لحظة ما بعد الدولة، حيث يُستبدل التمثيل بالامتثال، والسيادة بالعقود الوظيفية؟