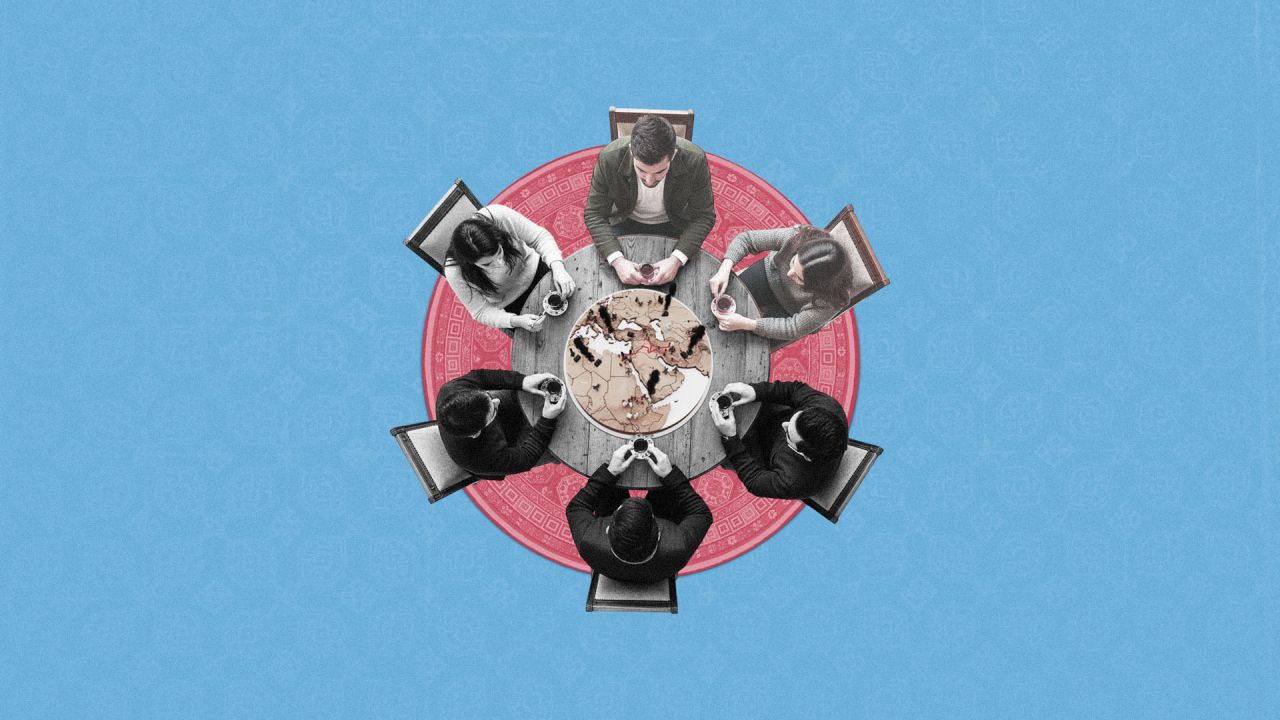
في إسطنبول، الأحاديث ولسبب ما خاطفة وقصيرة بالضرورة. لطالما انتظرتُ بفارغ الصبر اللحظة التي سأجد نفسي فيها متورطة بحديث طويلٍ عميق، من ذاك الذي يمتد لساعات. لكن في الغالب كان الأتراك يفقدون اهتمامهم بإكمال الدردشة معي بعد معرفتهم بأنّي سوريّة. لسبب ما، تجعلني تلك الحقيقة أقل جاذبية في نظرهم.
الأحاديث مع الأجانب القادمين إلى إسطنبول من إيران، وليبيا، وإيطاليا، وباكستان، بحثًا عن مكانٍ آمن أو تجربة عيش مختلفة، تُصنَّف من القياس "المتوسط". لكنها أيضًا لا ترقى لتُعد طويلة أو عميقة، فَالاسترسال والبوح يبدو انتهاكًا للمساحات الفردية. أعتقد أن الناس في مدينة كهذه يكرهون الأحاديث الطويلة، لأنها تُظهر لهم كمّ القواسم المشتركة مع "الأغراب" وتتحدى قناعاتهم الراسخة عن أنفسهم وعن الآخر.
"الأجسام أقرب مما تبدو في المرآة"، والقضايا أعقد مما تبدو حينما يناقشها أبناء البلد الواحد في ما بينهم. الحديث مع الأغراب، برغم قصره، يحمل نوعًا من الخفّة. تبدو القواسم أو "المصائب" المشتركة جليّة بصورة لا يمكن إنكارها. فيما يلي عينة من أحاديث مقتضبة تبادلتها مع رفاق ومعارف في إسطنبول قبل مغادرتها. جميع الأسماء الواردة في النص وهمية لحماية هوية أصحابها، لكنّ الأحاديث واقعية تمامًا، وهي حصلت حقًا.
كامران ــــ إيران
عيون كامران جاحظة ومتعبة جراء الأرق والتدخين المستمر. هو شابٌ أسمر طويل يصارع الاكتئاب ويؤلف نكاتًا عن الأمن التركي الذي يوقفه كل مرة، في كل محطة مترو، للتأكد من أوراقه الثبوتية.
أسأله عن أحوال أهله في إيران أثناء الضربات الإسرائيلية عليها. "كانوا سعداء، أمّي هلّلت للقصف"، يجيب بينما يدخن ويأخذ رشفات من قهوته الباردة. أحاول تذكيره بأن العامين المنصرمين حطّموا كذبة "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". يجيبني: "من المناسب أن نكون عاهرة أميركا. لقد جرّبنا هذا في الماضي كإيرانيين وناسبنا ذلك تمامًا. لا مشكلة لدي في أن أكون "America's bitch". أنا أفضّل ذلك على حكم المتطرفين".
أردتُ أن أجيبه بأن الشعوب للأسف "تتعلّم من كيسها"، أي تتعلّم بعد دفع أثمان باهظة مقابل مواقفها وآمالها الزائفة. لكنّ هيئته المتعبة وهو يحتسي القهوة في كاديكوي، جعلتني أُحجم عن قول المزيد. الحديث معه عن مساوئ التحالف مع الشيطان عبثي. غياب الديمقراطيات والكبت على الأنفاس يُعطل أحيانًا الحس السليم. بعد انقطاع يسألني هو عن أخبار سوريا، أجيبُه: "نحن في هذه البقعة من العالم نعيد تدوير المصائب ونتبادلها في ما بيننا، ديكتاتور يذهب تطرّف يأتي، تطرّف يذهب، إسرائيل تأتي...".
لورينزو ــــ إيطاليا
يرسل لي لورينزو، وهو صحفي إيطالي يكبرني ببضع سنوات، رسالة ساخطة في الأيام الأولى من مجزرة السويداء، المدينة التي زارها قبل شهرٍ واحد من بدء المصائب، ليُشاهد فيها الآثار التي تركها أجداده الرومانيون ويخطط لمقالة محتملة عن صناعة النبيذ المنزلي.
تقول الرسالة: "لا أفهم بماذا يفكرون في دمشق! لماذا لا يرسلون جيشًا مُحترفًا للتعامل مع الوضع في السويداء!".
أجيبه بعدما آخذ نفسًا طويلًا: "القيادة في دمشق أرادت أن يحصل ما حصل". وأستدرك بتوضيح إضافي أقول فيه إن هذا أكثر جيش "بروفشينال" تملكه الدولة السورية الآن: "الوضع لا يمكن أن يغدو بروفشينال أكثر من ذلك".
يختفي لورينزو أيام عدة ويعود ليكتب لي استنتاجًا جديدًا: "هناك ما هو مكسور في المجتمع السوري، هناك عنفٌ كثير، لا أعلم كيف يمكن إصلاح كل ذلك". أجيبه بينما كان أفراد عائلتي حبيسي دائرة العنف: "لماذا تُتعب رأسك بقضايا الشرق الأوسط، اذهب يا أخي واصنع قليلًا من البيتزا".
بعد أربع سنوات من الشكوى والاعتراض على عنصرية المجتمع التركي تُجاهنا نحن "السوريين"، اتضح أن الأتراك "حبّابين" مقارنة بنا
بعد ثلاثة أسابيع، يبعث لي برسالة جديدة يقول فيها: "ماذا يحصل يا نور؟ هناك الكثير من الأعلام الإسرائيلية!". ثم يضع عبارة معترضة: I am not judging.
أُخبره بألا شيء يُمكن أن يبرر رفع هذه الأعلام، وأنّي ضيّعت حياتي وأنا أخاف من إسرائيل لأخافها اليوم أكثر من أي وقت مضى. أخافها لأنها تحوّلت من وحش بعيد أراه في الأخبار، إلى وحش يلهو في باحة منازلنا الخلفية. كيف لوحش عظيم أن يضع ثقله بأكمله على مدينتي الصغيرة؟ من منحه فرصة تلميع صورته على حساب معاناتنا؟
سالم ــــ ليبيا
برغم أنه من ليبيا وأنا من سوريا، إلا أننا كنا نتواصل بالإنكليزية لأنها اللغة التي يفضّل الحديث بها، وهي اللغة التي يشعر فيها بتحررٍ وخفة ليعبّر عن هويته بأبعادها كافة. نستخدم لغةً وسيطة كي نتحرر من إرث التاريخ والمصائب المشتركة التي قذفتها بلادنا علينا.
خلال أيام المجزرة، يحاول سالم الذي يملك قطة وشعرًا مجعدًا فاحم السواد أن يطمئنّ عليّ، لكنّي أعجز عن الرد على رسائله. أطلب منه أخيرًا أن يُرسل لي أغنيات أجزي بها الوقت وأخرّب فيها صمت الشقة القاتل من حولي، فَيفعل ذلك. يرسل لي أغنية بالغة الرقة اسمها "Bosphorus". مشكلتها الوحيدة أنها الآن ارتبطت بذهني إلى الأبد بأسوأ أيام حياتي.
بعد أيام يكتب لي: "أتعرفين؟ كنتُ مرّة أحدث صديقًا لي في ليبيا عن احتلال إيطاليا لنا. الصديق قال لي في ذلك الوقت: كأن إيطاليا اخترعتنا كي تحتلنا". أقف مصدومة أمام صواب العبارة التي خرج بها سالم وصديقه. أشعر بها تخترقني حتى العظم. أحقًا هذا هو السبب الذي خُلقنا لأجله؟ كي يتسلّوا بنا ويستمتعوا بتأمّلنا فيما نحترق؟
زُلطان ــــ تركيا
إشعارٌ على هاتفي المحمول من تطبيق "إنستغرام". زُلطان، وهو فتى احتفالات ــــ "بارتي بوي" ـــ ومعارض شرس لسياسات أردوغان، يُرسل لي دون مقدمات: "ما مشكلة الإسلام السنّة مع الدروز؟". ألطم على رأسي وأجيبه بأن سؤاله معقد. وأحاول الخروج بإجابة تراعي الصوابية السياسية وتوضح القضية من وجهات نظر مختلفة. يستكمل بأنه يُحبّ "الدروز" أكثر من "سائر المسلمين"، برغم أنّي شبه موقنة أنه سمع بهذه الأقلية الدينية قبل أيام فقط.
لكنّ زُلطان لن يقف عند هذا الحد، يسألني: "هل كانت أوضاع الدروز أفضل خلال حكم بشار الأسد؟". أجيبه: "بشار الأسد استخدم الأقليات الدينية في سياسته كي يبدو بمظهر الرئيس المنفتح. لقد فرّق بين فئات المجتمع السوري على أساس طائفي وزاد الأمر سوءًا".
لا يبدو أن إجابتي أعجبته تمامًا، خصوصًا أن بشار الأسد، لسببٍ ما، يحظى بشعبية في أوساط المعارضة التركية. ربما لأنه طبيب يتحدث الإنكليزية وزوجته شديدة الاعتناء بمظهرها.
ينتقل بعدها ليسألني: "كم عدد الدروز؟". أجيبه متبرّمة بأنّي لا أعرف، وأنّي سأحاول إحصائهم له. أُغلق صندوق الرسائل الافتراضي وألعن الحظ والأقدار التي جعلت الأجانب الذين عشت بينهم أربعة أعوام يعلمون ــــ بعد المجازر الطائفية ــــ خلفيتي الدينية التي لم أفُصح عنها يومًا. فأنا لم أُعرّف عن نفسي إلا كسوريّة.
لا يُمكن القول إن زُلطان عنصري. إنّه شخص بالغ الرقة مع الجميع. لكنّ التفكير بـ"الإسلام" يُسبب له حكّة مثل الكثير من المعارضين الأتراك، الذين يرون فيه أصل مشكلاتهم. كثيرًا ما يستفزني تبسيطهم للأمور وعدائيتهم المفرطة تجاه معتقدات الآخرين. كما لو أن المجتمع التركي حبيس حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل. فالنساء المحجّبات في تركيا أُجبرن في مرحلة من المراحل على نزع الحجاب وخُيّرن بين ذلك وإكمال عملهنّ وتعليمهنّ. ففي عام 1997 (ما يُعرف بانقلاب ما بعد الحداثة)، تم تأسيس ما سُمّي بـ"غرف الإقناع" في الجامعات، حيث تُرغم الطالبات على خلع الحجاب تحت خطر الطرد. كان العداء للسوريين بالتالي، في أحد وجوهه، عداءً ضد الذات أو جوانب الهوية الدينية والمشرقية التي يريد المعارضون الأتراك طمسها تمامًا.
وبمناسبة الحديث عن الطائفية، بعد أربع سنوات من الشكوى والاعتراض على عنصرية المجتمع التركي تُجاهنا نحن "السوريين"، توقّفت في الآونة الأخيرة عن ذلك. اتضح أن الأتراك "حبّابين" مقارنة بنا، إذ على الأقل لم يرموا بنا من على شرفات المنازل. أقلّه حتى الآن.
رُكسانا ــــ إيران
نجلس، رُكسانا وسالم وأديل وأنا، في حديقة في بشيكتاش قبل أشهر من الآن للاحتفال بعيد ميلاد سالم. نحن الذين تعرفنا إلى بعضنا في نادي لهواة "الستاند أب كوميدي" في إسطنبول.
يكمل سالم ورُكسانا نقاشًا بدآه عن إسرائيل. رُكسانا تجلس مرتديةً ثيابًا سوداء بعدما أسدلت شعرها الأسود على كتفيها ورسمت كحلًا فوق عينيها. تقول إنها ترحب بالضربات الإسرائيلية على بلادها وتؤكد، بقناعة تامة، ألا شيء يمكن أن يكون أكثر سوءًا من وضع بلدها الحالي.
ننظر أنا وسالم إلى بعضنا البعض ونضحك. هو من ليبيا وأنا من سوريا. نؤكد لها أن هناك بالتأكيد ما هو أسوأ من الذي عاشته حتى الآن. تتجنب الشابة زيارة إيران منذ سنوات، وأكاد لا أستطيع تخيّل طبعها الناري وشخصيتها الصارخة في مكانٍ يقيدُ حرية النساء ويتحكم بهنّ. أتعاطف معها، لكنّي أعلم أن الغضب يعميها.
أنظر إليها مليًّا وأشعر أنّي أمام مشهد "ديجافو" ـــــ "وهم سبق الرؤية". لقد رأيت في مرات لا تُحصى سابقًا أناسًا مثلها يتحدثون باليقين ذاته والأمل ذاته. من أين أتينا كشعوب في هذه البقعة من الأرض بعبارة "ليس هناك أسوأ مما نعيشه" الواهمة؟ الدنيا في الحقيقة تُذهلنا بشتى أنواع السيناريوهات الأسوأ التي لم تخطر على بالنا. أفكّر مجددًا بإعادة تدوير المصائب في هذه البقعة من الأرض: حاضر رُكسانا وكامران هو مستقبلنا. وحاضرنا، سالم وأنا، هو مستقبلهما.
