
لقاء مع يوسف عبدلكي أجرته هنادي زرقه
- يوسف عبدلكي، ثمة عنف في لوحاتك، وفقد وغياب. قد يرتجف المرء أمام لوحة الحذاء النسائي المتروك... وكذلك أمام رأس السمكة المقطوع، والجمجمة، والسكين المغروسة في الخشب وبقربها عصفور. كيف يمكن أن نحبَّ العنف والفقد في لوحة، هل يمكن لهذا أن يكون جميلاً، كما يقتضي الفن؟
- العنف جزء من تاريخ البشرية، حتى في المجتمعات ما قبل الطبقية. قبل ١٠ آلاف سنة فقط، كان يمكن للجماعات (القطعان) البشرية في أوقات الشح والجوع أن تذبح أحد الأطفال لتأكل العائلة.
الحروب عنف، الاعتقال السياسي عنف، حروب المصالح عنف، الحروب الدينية عنف، الاستغلال عنف، والفقر عنف. لذلك لا يستقيم السؤال عن العنف. الأجدر أن نسأل الفنانين المزيّنين، اللطفاء، النجباء، التجاريين، مروجي السعادة الكاذبة عن سبب خيانتهم للواقع، لحياة البشر، لحياتهم!
هذا أولاً، ثانياً العنف والجمال في الفن شيء آخر غير العنف والجمال في الواقع. العنف في الواقع تخلف، بربرية. أمّا العنف وتصعيد التعبير في الفن فلا يتناقض مع الجمال، في كثير من الأحيان يصبح هو الجمال. وجوه سوتين وغورنيكا بيكاسو وأجساد بيكون وحيطان تابييس، أعمال شديدة العنف، لكنها في الآن نفسه قمم حقيقية في الجمال الفني، في الإبداع الجديد. في اللوحة لا نتفرج على الواقع. نتفرج على تلاطم العواطف لدى الرسام، مشاعره، إبداع أشكاله وعجائن ألوانه المخضبة بمأساة الكائن البشري.
 - تحضر النساء في لوحاتك ذواتاً مهشّمة، سواء كنّ أمهات لشهداء أم فتيات عاريات. أكاد لا أتبيّن امرأة واحدة قوية في هذه اللوحات. حتى أمّ الشهيد التي تبدو متمالكة نفسها، يكاد قهرها وعجزها يفترسانها بكلّ يسر. لم هذا الإصرار على رسم المرأة محطمةً؟
- إذا كانت أمهات الشهداء اللواتي رسمتهن نساء محطمات فهذا يعني أني رسام فاشل.
الأمهات في لوحاتي نساء قويات. لا يستجدين عاطفة، ولا يستعطفن شفقة. يطالبن بأبنائهن، يطالبن بالعدالة، ويرونها في هذه الحياة، أصوات عيونهم المكتومة تريد الاقتصاص من القتلة. لا مكان للحطام في ذلك.
أمّا النساء العاريات فلا أخفي عليك أنهن أمر آخر. رسمتهن في لحظة صعود الفاشية الدينية كما ظهرت عند "داعش" و"النصرة" وغيرهما. كنت أحسّ أن الثورة السورية تحطمت. حطمها عنف النظام وتدخلات الخارج تسليحاً وتمويلاً. حولوها إلى حلقة بشعة في لعبة الأمم. أصبحت الثورة السورية كل شيء إلا كونها ثورة. صراع وحشي دولي وإقليمي وطائفي. بدلاً من أن يأخذ السوريين إلى الحرية والديمقراطية أخذهم إلى القتل والموت والدمار والمجازر وتحطيم وشائج أبناء البلد الواحد.
- تحضر النساء في لوحاتك ذواتاً مهشّمة، سواء كنّ أمهات لشهداء أم فتيات عاريات. أكاد لا أتبيّن امرأة واحدة قوية في هذه اللوحات. حتى أمّ الشهيد التي تبدو متمالكة نفسها، يكاد قهرها وعجزها يفترسانها بكلّ يسر. لم هذا الإصرار على رسم المرأة محطمةً؟
- إذا كانت أمهات الشهداء اللواتي رسمتهن نساء محطمات فهذا يعني أني رسام فاشل.
الأمهات في لوحاتي نساء قويات. لا يستجدين عاطفة، ولا يستعطفن شفقة. يطالبن بأبنائهن، يطالبن بالعدالة، ويرونها في هذه الحياة، أصوات عيونهم المكتومة تريد الاقتصاص من القتلة. لا مكان للحطام في ذلك.
أمّا النساء العاريات فلا أخفي عليك أنهن أمر آخر. رسمتهن في لحظة صعود الفاشية الدينية كما ظهرت عند "داعش" و"النصرة" وغيرهما. كنت أحسّ أن الثورة السورية تحطمت. حطمها عنف النظام وتدخلات الخارج تسليحاً وتمويلاً. حولوها إلى حلقة بشعة في لعبة الأمم. أصبحت الثورة السورية كل شيء إلا كونها ثورة. صراع وحشي دولي وإقليمي وطائفي. بدلاً من أن يأخذ السوريين إلى الحرية والديمقراطية أخذهم إلى القتل والموت والدمار والمجازر وتحطيم وشائج أبناء البلد الواحد.
 - أنت شخص ساخر، ولاذع، رسمت الكاريكاتير منذ سنة ١٩٦٦، لماذا توقف ذلك أو كاد يتوقف؟
- هل تعرفين رسام كاريكاتير مهم واحد اليوم؟ أسألك؟ لن تجدي. السبب هو أنّ الكاريكاتير ابن الحرية، ابن حرية الصحافة، ابن الآمال الكبرى. في الخمسينيات والستينيات رأينا كوكبة من أروع الرساميين المصريين: البهجوري، حجازي، بهجت، جاهين، الليثي.. إلخ. كانت فترة صعود قومي. الواقع متخلف، لكن الآمال عريضة، تريد أن تقتحم السماء.
كنا نعتقد أننا سنتوحد كعرب، سنقبر التخلف والأمية، والمرض، والفقر... وإسرائيل أيضاً. في هذه اللحظة الفارقة ظهرت تلك الكوكبة البديعة. في السبعينيات، مع الحرب الأهلية اللبنانية، رأينا ناجي العلي كأنه حامل مشعل فلسطين وانتصار اليسار اللبناني على الفاشية الموالية لإسرائيل. لو جاء اليوم ناجي العلي لما وجد جريدة عربية واحدة تنشر رسومه. الكاريكاتور ابن المعارك الكبرى والآمال الكبرى. من أين يأتي الكاريكاتير الحقيقي اليوم والزعماء العرب يحجون كالخراف الذليلة إلى واشنطن! والأجيال العربية في وهدة اليأس!
اليوم لدينا عدد كبير من الرسامين المحترفين المهرة، لكن نفتقد الواقع الذي يفجر مواهب هؤلاء، ويفتح لهم صدر الصحافة الحرّة، ويصنع من كل واحد منهم عشرة جاهينات وعشرة ناجيات وعشرة بهجاتوسات. بدل أن تكون الصحافة صوت الناس وسلطتهم أصبحت عدوّة الحرية وعدوة الشعوب العربية. أصبح النفط سيد الصحافة. وأصبح الدولار السعودي هو رئيس تحرير أغلب الصحف العربية. هل تعرفين صحيفة عربية واحدة تنتقد سياسات العربية السعودية مثلاً!
- أنت شخص ساخر، ولاذع، رسمت الكاريكاتير منذ سنة ١٩٦٦، لماذا توقف ذلك أو كاد يتوقف؟
- هل تعرفين رسام كاريكاتير مهم واحد اليوم؟ أسألك؟ لن تجدي. السبب هو أنّ الكاريكاتير ابن الحرية، ابن حرية الصحافة، ابن الآمال الكبرى. في الخمسينيات والستينيات رأينا كوكبة من أروع الرساميين المصريين: البهجوري، حجازي، بهجت، جاهين، الليثي.. إلخ. كانت فترة صعود قومي. الواقع متخلف، لكن الآمال عريضة، تريد أن تقتحم السماء.
كنا نعتقد أننا سنتوحد كعرب، سنقبر التخلف والأمية، والمرض، والفقر... وإسرائيل أيضاً. في هذه اللحظة الفارقة ظهرت تلك الكوكبة البديعة. في السبعينيات، مع الحرب الأهلية اللبنانية، رأينا ناجي العلي كأنه حامل مشعل فلسطين وانتصار اليسار اللبناني على الفاشية الموالية لإسرائيل. لو جاء اليوم ناجي العلي لما وجد جريدة عربية واحدة تنشر رسومه. الكاريكاتور ابن المعارك الكبرى والآمال الكبرى. من أين يأتي الكاريكاتير الحقيقي اليوم والزعماء العرب يحجون كالخراف الذليلة إلى واشنطن! والأجيال العربية في وهدة اليأس!
اليوم لدينا عدد كبير من الرسامين المحترفين المهرة، لكن نفتقد الواقع الذي يفجر مواهب هؤلاء، ويفتح لهم صدر الصحافة الحرّة، ويصنع من كل واحد منهم عشرة جاهينات وعشرة ناجيات وعشرة بهجاتوسات. بدل أن تكون الصحافة صوت الناس وسلطتهم أصبحت عدوّة الحرية وعدوة الشعوب العربية. أصبح النفط سيد الصحافة. وأصبح الدولار السعودي هو رئيس تحرير أغلب الصحف العربية. هل تعرفين صحيفة عربية واحدة تنتقد سياسات العربية السعودية مثلاً!
 - لا تزال متقشفاً تستخدم الأبيض والأسود وحدهما. لماذا؟ هل الأسباب فنية أم لها علاقة بالوضع خارج اللوحة؟ هل يمكن أن نرى لك مستقبلاً لوحات بالألوان؟
- لقد تحدثت أكثر من مرة حول خيار الأبيض والأسود، وعن أن التشكيليين ينقسمون إلى فئتين عريضتين: الرسامون والملونون. وهما تركيبان مختلفان تقنياً ونفسياً حيث يعمل الأولون على الخط والمساحة السوداء وبأدوات صلبة، ويعمل الآخرون على تناغمات الألوان الحارة والباردة وتناقضاتها وبأدوات طرية كالفرشاة. غنيٌّ عن القول أن التيارين مفتوحين واحدهما على الآخر تماماً، فآلاف الرسامين عملوا بالألوان وآلاف الملونين عملوا بالأبيض والأسود. غير أن التحكّم والجمال لدى كل تشكيلي يظهر أكثر ما يظهر عندما يعمل في حقله هو. بناءً عليه، أنا أرسم بالأبيض والأسود لاعتقادي أني أستطيع أن أحقق بهما نتائج أفضل. وبعبارة أخرى لا علاقة لذلك بأي تقشف أو أي معانٍ مأساوية للون الأسود.
الفنانون عموماً ينقسمون الى فئتين عريضتين بالنسبة لواحدية عملهم أو إلى تعدادها. هناك من يعمل على أسلوبه وموضوعه وتقنيته الواحدة عمره كله تقريباً، مثلما كان حال جياكوميتي أو فاتح المدرس. وهناك من نوّع أسلوباً وموضوعاً وتقنية أمثال بيكاسو وجواد سليم وصليبا الدويهي ونذير نبعة. الأخير، مثلاً، عمل في الستينيات على الأساطير بتقنية واقعية ثم تحوّل الى أشخاصه المبسّطة ذات اللون الأصفر الصحراوي، ثم عمل خلال دراسته في فرنسا على التجريد المستوحى من الأشكال النباتية، ثم قبل التجريد وبعده عمل على الموضوعات الشرقية في السبعينيات والثمانينيات، وختم العشرين سنة الأخيرة من حياته بالتجريد المستمد من تموضعات الصخور في الجبال... هذا إضافة الى أعمال الحبر الصيني بلمساته المسحوبة بالأصبع، وإضافة أيضاً إلى أغلفة الكتب والملصقات ورسوم كتب الأطفال، مسيرة غنية غنىً بديعاً. أعتقد أن تعقيدات العواطف والأفكار أولاً، والانتقال من الشباب الى الرجولة الى الشيخوخة ثانياً، وتنوع الحياة السياسية والاجتماعية وتقلباتها حولنا ثالثاً، يدفعنا أكثر الى طرح الأسئلة الجديدة، وابتكار المواضيع والأشكال الجديدة غير المألوفة أو غير المطروقة على الأقل بالنسبة إلى الفنان نفسه. هكذا يصبح تنوع عمل الفنان جزءًا أساسياً من اسئلته وشكّه على مدار الحياة.
رغم انغماسي بالرسم منذ خمسين عاماً فأنا كثيراً ما أفكر بوسائط أخرى، مثل النحت أو الخزف والألوان. أنجزتُ مثلاً في السنوات العشر الماضية ما يقارب من مئتي قطعة خزف، غير أني أعتبر نفسي هاوياً يتعرف على المواد ليس غير.
كما عملت مجموعة "أشخاص" بين عامي ١٩٨٩–١٩٩٥ وهي بالألوان الترابية وألوان الباستيل، غير أني أعتقد أن بنيتها غرافيكية على عكس ما يوحي للوهلة الأولى مظهرها.
الأبيض والأسود ملعبي، لكن المجالات الأخرى أراها دائماً مغرية، بغض النظر عن أنها ستكون مساراً آخراً أو نزوةً عابرة.
- لا تزال متقشفاً تستخدم الأبيض والأسود وحدهما. لماذا؟ هل الأسباب فنية أم لها علاقة بالوضع خارج اللوحة؟ هل يمكن أن نرى لك مستقبلاً لوحات بالألوان؟
- لقد تحدثت أكثر من مرة حول خيار الأبيض والأسود، وعن أن التشكيليين ينقسمون إلى فئتين عريضتين: الرسامون والملونون. وهما تركيبان مختلفان تقنياً ونفسياً حيث يعمل الأولون على الخط والمساحة السوداء وبأدوات صلبة، ويعمل الآخرون على تناغمات الألوان الحارة والباردة وتناقضاتها وبأدوات طرية كالفرشاة. غنيٌّ عن القول أن التيارين مفتوحين واحدهما على الآخر تماماً، فآلاف الرسامين عملوا بالألوان وآلاف الملونين عملوا بالأبيض والأسود. غير أن التحكّم والجمال لدى كل تشكيلي يظهر أكثر ما يظهر عندما يعمل في حقله هو. بناءً عليه، أنا أرسم بالأبيض والأسود لاعتقادي أني أستطيع أن أحقق بهما نتائج أفضل. وبعبارة أخرى لا علاقة لذلك بأي تقشف أو أي معانٍ مأساوية للون الأسود.
الفنانون عموماً ينقسمون الى فئتين عريضتين بالنسبة لواحدية عملهم أو إلى تعدادها. هناك من يعمل على أسلوبه وموضوعه وتقنيته الواحدة عمره كله تقريباً، مثلما كان حال جياكوميتي أو فاتح المدرس. وهناك من نوّع أسلوباً وموضوعاً وتقنية أمثال بيكاسو وجواد سليم وصليبا الدويهي ونذير نبعة. الأخير، مثلاً، عمل في الستينيات على الأساطير بتقنية واقعية ثم تحوّل الى أشخاصه المبسّطة ذات اللون الأصفر الصحراوي، ثم عمل خلال دراسته في فرنسا على التجريد المستوحى من الأشكال النباتية، ثم قبل التجريد وبعده عمل على الموضوعات الشرقية في السبعينيات والثمانينيات، وختم العشرين سنة الأخيرة من حياته بالتجريد المستمد من تموضعات الصخور في الجبال... هذا إضافة الى أعمال الحبر الصيني بلمساته المسحوبة بالأصبع، وإضافة أيضاً إلى أغلفة الكتب والملصقات ورسوم كتب الأطفال، مسيرة غنية غنىً بديعاً. أعتقد أن تعقيدات العواطف والأفكار أولاً، والانتقال من الشباب الى الرجولة الى الشيخوخة ثانياً، وتنوع الحياة السياسية والاجتماعية وتقلباتها حولنا ثالثاً، يدفعنا أكثر الى طرح الأسئلة الجديدة، وابتكار المواضيع والأشكال الجديدة غير المألوفة أو غير المطروقة على الأقل بالنسبة إلى الفنان نفسه. هكذا يصبح تنوع عمل الفنان جزءًا أساسياً من اسئلته وشكّه على مدار الحياة.
رغم انغماسي بالرسم منذ خمسين عاماً فأنا كثيراً ما أفكر بوسائط أخرى، مثل النحت أو الخزف والألوان. أنجزتُ مثلاً في السنوات العشر الماضية ما يقارب من مئتي قطعة خزف، غير أني أعتبر نفسي هاوياً يتعرف على المواد ليس غير.
كما عملت مجموعة "أشخاص" بين عامي ١٩٨٩–١٩٩٥ وهي بالألوان الترابية وألوان الباستيل، غير أني أعتقد أن بنيتها غرافيكية على عكس ما يوحي للوهلة الأولى مظهرها.
الأبيض والأسود ملعبي، لكن المجالات الأخرى أراها دائماً مغرية، بغض النظر عن أنها ستكون مساراً آخراً أو نزوةً عابرة.
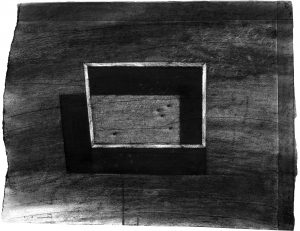 - يوسف، أنت تبدو كمن أُطعِمَ الحج والناس راجعة. تعود إلى دمشق وتبقى فيها في الوقت ذاته الذي وجد معارضون، ومنهم رفاق لك سابقون، أنّ ما انطلق في سوريا 2011 فرصة للخروج منها. وبلغت قناعتهم في ذلك حد تجريم من بقوا واتهامهم. ما الذي يبقيك في دمشق على الرغم من المخاطر التي أحاقت وتحيق بك؟
- أصبحت مسألة المعارضة في الداخل والخارج مسألة تستحق التوقف طويلاً. وأصبحت حملات المعارضين في الخارج ضد المعارضين في الداخل ظاهرة تخرج عن كونها فعلاً فردياً. وأحد أسباب ذلك أن الكتابة على "فيسبوك" ليس لها من ضابط يضبطها إلا حكمة الشخص وأخلاقه! وهذه ليست متساوية لدى البشر لا في الداخل ولا في الخارج.
الأمر الثاني الأهم هو بعدها النفسي–السياسي. معارض الداخل يثير الحنق، لأن مجرد وجوده في الداخل يشكل تحدياً لمعارض الخارج وينزع منه مبررات خروجه. ولا سبيل للرد على ذلك الحنق المبرر إلا رمي معارضي الداخل بشتى التهم.
تبلغ الشتائم في بعض الأحيان درجة لا أخلاقية! كأن معارضي الداخل هم الذين كانوا يرمون حلب بالبراميل المتفجرة! وحدوا اللّه! وتبلغ أحياناً درجة مضحكة. أحد المعماريين الممسوسين في الخارج والذي عاش أربعين عاماً في الداخل كالأرنب، يشتمني على الطالع والنازل مستحضراً المعمارية العظيمة زها حديد. لا أعرف إن كان صاحبنا متحاملاً أم مختلّاً، فهو ينسى أن زها حديد معماريّة عظيمة لأنها أنجزت تسعمائة وخمسين مشروعاً معمارياً جديداً، وليس لأنها استمرأت عطالتها وجلست وراء كمبيوترها وراحت تشتم على "فيسبوك" من يعملون. هكذا تصبح للثرثرة واستسهال شتم الآخرين وظيفة: مشجب نعلق عليه عطالتنا وخوائنا المهني.
يخطر ببال المعارضين في الداخل أن يسألوا أولئك دائماً: إذا كنا مقصّرين فتعالوا وأنجزوا أفضل منّا. غير أن الرد جاهز: لدينا ظروف أمنية! طيب.. هذا صحيح، ولكن هل المعارضون في الداخل يعيشون في سويسرا! هم واقعون تحت نفس الضغوط التي تهربون منها! رغم كل ذلك أنا أتعاطف مع المعارضين "الفيسبوكيين" في الخارج لأنهم ضحايا النظام. لذلك هم معذورون عندما يخطئون في التحليل أو في الحكم على من هم في الداخل. سبق أن عانيت ظروف الغربة لمدة أربعة وعشرين عاماً. أعرف ما معنى أن تكون مقتلعاً من بلدك بالقوة. آمل أن تسكّن قلوبهم الحكمة يوماً ويرون الكارثة التي تنهكنا جميعاً في الداخل والخارج؟!
- يوسف، أنت تبدو كمن أُطعِمَ الحج والناس راجعة. تعود إلى دمشق وتبقى فيها في الوقت ذاته الذي وجد معارضون، ومنهم رفاق لك سابقون، أنّ ما انطلق في سوريا 2011 فرصة للخروج منها. وبلغت قناعتهم في ذلك حد تجريم من بقوا واتهامهم. ما الذي يبقيك في دمشق على الرغم من المخاطر التي أحاقت وتحيق بك؟
- أصبحت مسألة المعارضة في الداخل والخارج مسألة تستحق التوقف طويلاً. وأصبحت حملات المعارضين في الخارج ضد المعارضين في الداخل ظاهرة تخرج عن كونها فعلاً فردياً. وأحد أسباب ذلك أن الكتابة على "فيسبوك" ليس لها من ضابط يضبطها إلا حكمة الشخص وأخلاقه! وهذه ليست متساوية لدى البشر لا في الداخل ولا في الخارج.
الأمر الثاني الأهم هو بعدها النفسي–السياسي. معارض الداخل يثير الحنق، لأن مجرد وجوده في الداخل يشكل تحدياً لمعارض الخارج وينزع منه مبررات خروجه. ولا سبيل للرد على ذلك الحنق المبرر إلا رمي معارضي الداخل بشتى التهم.
تبلغ الشتائم في بعض الأحيان درجة لا أخلاقية! كأن معارضي الداخل هم الذين كانوا يرمون حلب بالبراميل المتفجرة! وحدوا اللّه! وتبلغ أحياناً درجة مضحكة. أحد المعماريين الممسوسين في الخارج والذي عاش أربعين عاماً في الداخل كالأرنب، يشتمني على الطالع والنازل مستحضراً المعمارية العظيمة زها حديد. لا أعرف إن كان صاحبنا متحاملاً أم مختلّاً، فهو ينسى أن زها حديد معماريّة عظيمة لأنها أنجزت تسعمائة وخمسين مشروعاً معمارياً جديداً، وليس لأنها استمرأت عطالتها وجلست وراء كمبيوترها وراحت تشتم على "فيسبوك" من يعملون. هكذا تصبح للثرثرة واستسهال شتم الآخرين وظيفة: مشجب نعلق عليه عطالتنا وخوائنا المهني.
يخطر ببال المعارضين في الداخل أن يسألوا أولئك دائماً: إذا كنا مقصّرين فتعالوا وأنجزوا أفضل منّا. غير أن الرد جاهز: لدينا ظروف أمنية! طيب.. هذا صحيح، ولكن هل المعارضون في الداخل يعيشون في سويسرا! هم واقعون تحت نفس الضغوط التي تهربون منها! رغم كل ذلك أنا أتعاطف مع المعارضين "الفيسبوكيين" في الخارج لأنهم ضحايا النظام. لذلك هم معذورون عندما يخطئون في التحليل أو في الحكم على من هم في الداخل. سبق أن عانيت ظروف الغربة لمدة أربعة وعشرين عاماً. أعرف ما معنى أن تكون مقتلعاً من بلدك بالقوة. آمل أن تسكّن قلوبهم الحكمة يوماً ويرون الكارثة التي تنهكنا جميعاً في الداخل والخارج؟!
 - تبدو عكس التيار و"دقّة قديمة" حتى فكرياً وسياسياً وأيديولوجياً. يا رجل، كيف يمكن لفنان من وزنك أن يكون متحزّباً إلى هذا الحدّ؟ وكيف يمكن لرهاناته أن تبقى عند "الكادحين" بعيداً عن الإعجاب بالعالم الحرّ الذي راح رفاق لك كثيرون يتغنون به ويتوسّلون إنقاذه؟
- يحتاج هذا السؤال إلى مجلد للإجابة عنه. لتعدد مستوياته، وإمكانات الاستفاضة في التحليل في كل مستوى. في البداية أود القول إني أكاد لا أعرف أي كاتب أو شاعر أو رسام إلا وكان متحزباً، أو كان متحزباً في يوم ما، في بلادنا وفي العالم، من كبار شعراء العربية إلى أهم أسماء التشكيليين، من درويش وأدونيس ومنيف والفيتوري وجلال خوري وونوس إلى مروان ومدرس ونبعه ورمسيس يونان وحامد عويس... إلخ. ربما يظن بعض المثقفين أن الإعلان عن الانتماء السياسي يضيّق مجال تأثيرهم، بينما وظيفة المثقف أن يخاطب الجمهور الواسع. أعتقد أن في الأمر لبسًا ما؛ وهو الخلط بين الانتماء السياسي والعمل الفني أو الأدبي. العمل السياسي يومي، تفاصيلي، بينما حقل العمل الفني وهدفه العالم كله والبشر أجمعين، وعلى مدى زمني طويل. على الإنتاج الثقافي أن يرى أوسع من هموم السياسة اليومية، وهذا هو التحدي: انتمى درويش الى الحزب الشيوعي ولكن شعره كان ضمير فلسطين ومقاومة شعبها، ورأى فيه العرب صورة مأزقهم وقوة أحلامهم.
ثم إنَّ انتمائي، في معناه العريض، هو احتجاج على الظلم، بحث عن العدالة، وعن شيء من الحرية، وعن شيء من العقلانية في السياسة. وبصراحة، لا أجد في ذلك ما يضيرني أو ما أتهرّب منه!
أما التغني بالعالم الحر الذي صنع على مدى القرون الثلاثة الماضية بعرق ودم ملايين العمال والفلاحين في أوروبا وأمريكا، ثم من استعمار ثلاثة أرباع شعوب الكرة الأرضية، وثم من نهب ثروات شعوب العالم وإفقارها وإذلالها.. فهذا العالم الحر، رغم كل تقدمه التقني والصناعي والإداري والثقافي، لا يسعدني قطّ أن أتغنى به وبمفاخره الوحشية. هو نفس العالم الحر الذي دمر العراق ونهبه وفتته منذ ١٧ عاماً، ودمر ويدمر ليبيا وسوريا واليمن اليوم. لو كان الغرب صانعاً للحرية والديمقراطية لوقفت إلى جانبه كل شعوب الأرض. الاتكال على الغرب لا يعكس إلا تغييبنا لعقلنا أولاً، وطمساً للوقائع المفجعة حولنا ثانياً، وثالثاً يعكس يأسنا من إمكانات التغيير بيد شعبنا نفسه. ليس جديداً أنّ كثيراً من النخب قصيرة النفس. وهي تغطي ذلك برطانة سياسية وفكرية لا تقنع حتى الرضّع!
على المقلب الآخر، تجد العالم الثالث وأنظمته الديكتاتورية التابعة للغرب والتي لا تنفق المليارات على شراء الأسلحة إلا لاستخدامها ضد شعوبها نفسها (وليس ضد أي عدو خارجي)! ذلك أن وظيفة السلاح هي حماية الاستغلال والنهب المنظم والفساد.
طالما العدالة غائبة عن هذا العالم فشرف الإنسان أن يكون في صف البشر، في صفّ الأُجراء المقهورين الباحثين عن لقمة الخبز، ولقمة الحرية، ولقمة الكرامة.
طالما أن هناك ٢٦ غنياً فقط يملكون أكثر من ٥٠٪ مما يملكه كل فقراء العالم، فالعدالة ستبقى هاجساً للبشرية.
- تبدو عكس التيار و"دقّة قديمة" حتى فكرياً وسياسياً وأيديولوجياً. يا رجل، كيف يمكن لفنان من وزنك أن يكون متحزّباً إلى هذا الحدّ؟ وكيف يمكن لرهاناته أن تبقى عند "الكادحين" بعيداً عن الإعجاب بالعالم الحرّ الذي راح رفاق لك كثيرون يتغنون به ويتوسّلون إنقاذه؟
- يحتاج هذا السؤال إلى مجلد للإجابة عنه. لتعدد مستوياته، وإمكانات الاستفاضة في التحليل في كل مستوى. في البداية أود القول إني أكاد لا أعرف أي كاتب أو شاعر أو رسام إلا وكان متحزباً، أو كان متحزباً في يوم ما، في بلادنا وفي العالم، من كبار شعراء العربية إلى أهم أسماء التشكيليين، من درويش وأدونيس ومنيف والفيتوري وجلال خوري وونوس إلى مروان ومدرس ونبعه ورمسيس يونان وحامد عويس... إلخ. ربما يظن بعض المثقفين أن الإعلان عن الانتماء السياسي يضيّق مجال تأثيرهم، بينما وظيفة المثقف أن يخاطب الجمهور الواسع. أعتقد أن في الأمر لبسًا ما؛ وهو الخلط بين الانتماء السياسي والعمل الفني أو الأدبي. العمل السياسي يومي، تفاصيلي، بينما حقل العمل الفني وهدفه العالم كله والبشر أجمعين، وعلى مدى زمني طويل. على الإنتاج الثقافي أن يرى أوسع من هموم السياسة اليومية، وهذا هو التحدي: انتمى درويش الى الحزب الشيوعي ولكن شعره كان ضمير فلسطين ومقاومة شعبها، ورأى فيه العرب صورة مأزقهم وقوة أحلامهم.
ثم إنَّ انتمائي، في معناه العريض، هو احتجاج على الظلم، بحث عن العدالة، وعن شيء من الحرية، وعن شيء من العقلانية في السياسة. وبصراحة، لا أجد في ذلك ما يضيرني أو ما أتهرّب منه!
أما التغني بالعالم الحر الذي صنع على مدى القرون الثلاثة الماضية بعرق ودم ملايين العمال والفلاحين في أوروبا وأمريكا، ثم من استعمار ثلاثة أرباع شعوب الكرة الأرضية، وثم من نهب ثروات شعوب العالم وإفقارها وإذلالها.. فهذا العالم الحر، رغم كل تقدمه التقني والصناعي والإداري والثقافي، لا يسعدني قطّ أن أتغنى به وبمفاخره الوحشية. هو نفس العالم الحر الذي دمر العراق ونهبه وفتته منذ ١٧ عاماً، ودمر ويدمر ليبيا وسوريا واليمن اليوم. لو كان الغرب صانعاً للحرية والديمقراطية لوقفت إلى جانبه كل شعوب الأرض. الاتكال على الغرب لا يعكس إلا تغييبنا لعقلنا أولاً، وطمساً للوقائع المفجعة حولنا ثانياً، وثالثاً يعكس يأسنا من إمكانات التغيير بيد شعبنا نفسه. ليس جديداً أنّ كثيراً من النخب قصيرة النفس. وهي تغطي ذلك برطانة سياسية وفكرية لا تقنع حتى الرضّع!
على المقلب الآخر، تجد العالم الثالث وأنظمته الديكتاتورية التابعة للغرب والتي لا تنفق المليارات على شراء الأسلحة إلا لاستخدامها ضد شعوبها نفسها (وليس ضد أي عدو خارجي)! ذلك أن وظيفة السلاح هي حماية الاستغلال والنهب المنظم والفساد.
طالما العدالة غائبة عن هذا العالم فشرف الإنسان أن يكون في صف البشر، في صفّ الأُجراء المقهورين الباحثين عن لقمة الخبز، ولقمة الحرية، ولقمة الكرامة.
طالما أن هناك ٢٦ غنياً فقط يملكون أكثر من ٥٠٪ مما يملكه كل فقراء العالم، فالعدالة ستبقى هاجساً للبشرية.
 - تحضر النساء في لوحاتك ذواتاً مهشّمة، سواء كنّ أمهات لشهداء أم فتيات عاريات. أكاد لا أتبيّن امرأة واحدة قوية في هذه اللوحات. حتى أمّ الشهيد التي تبدو متمالكة نفسها، يكاد قهرها وعجزها يفترسانها بكلّ يسر. لم هذا الإصرار على رسم المرأة محطمةً؟
- إذا كانت أمهات الشهداء اللواتي رسمتهن نساء محطمات فهذا يعني أني رسام فاشل.
الأمهات في لوحاتي نساء قويات. لا يستجدين عاطفة، ولا يستعطفن شفقة. يطالبن بأبنائهن، يطالبن بالعدالة، ويرونها في هذه الحياة، أصوات عيونهم المكتومة تريد الاقتصاص من القتلة. لا مكان للحطام في ذلك.
أمّا النساء العاريات فلا أخفي عليك أنهن أمر آخر. رسمتهن في لحظة صعود الفاشية الدينية كما ظهرت عند "داعش" و"النصرة" وغيرهما. كنت أحسّ أن الثورة السورية تحطمت. حطمها عنف النظام وتدخلات الخارج تسليحاً وتمويلاً. حولوها إلى حلقة بشعة في لعبة الأمم. أصبحت الثورة السورية كل شيء إلا كونها ثورة. صراع وحشي دولي وإقليمي وطائفي. بدلاً من أن يأخذ السوريين إلى الحرية والديمقراطية أخذهم إلى القتل والموت والدمار والمجازر وتحطيم وشائج أبناء البلد الواحد.
- تحضر النساء في لوحاتك ذواتاً مهشّمة، سواء كنّ أمهات لشهداء أم فتيات عاريات. أكاد لا أتبيّن امرأة واحدة قوية في هذه اللوحات. حتى أمّ الشهيد التي تبدو متمالكة نفسها، يكاد قهرها وعجزها يفترسانها بكلّ يسر. لم هذا الإصرار على رسم المرأة محطمةً؟
- إذا كانت أمهات الشهداء اللواتي رسمتهن نساء محطمات فهذا يعني أني رسام فاشل.
الأمهات في لوحاتي نساء قويات. لا يستجدين عاطفة، ولا يستعطفن شفقة. يطالبن بأبنائهن، يطالبن بالعدالة، ويرونها في هذه الحياة، أصوات عيونهم المكتومة تريد الاقتصاص من القتلة. لا مكان للحطام في ذلك.
أمّا النساء العاريات فلا أخفي عليك أنهن أمر آخر. رسمتهن في لحظة صعود الفاشية الدينية كما ظهرت عند "داعش" و"النصرة" وغيرهما. كنت أحسّ أن الثورة السورية تحطمت. حطمها عنف النظام وتدخلات الخارج تسليحاً وتمويلاً. حولوها إلى حلقة بشعة في لعبة الأمم. أصبحت الثورة السورية كل شيء إلا كونها ثورة. صراع وحشي دولي وإقليمي وطائفي. بدلاً من أن يأخذ السوريين إلى الحرية والديمقراطية أخذهم إلى القتل والموت والدمار والمجازر وتحطيم وشائج أبناء البلد الواحد.
في لحظة اليأس من تحول الثورة العظيمة إلى كارثة لجأت إلى العمل على الجسد العاري. كأني أهرب إلى الجمال من الواقع البشعرأيت ظهور وأرجل مساجين عند عودتهم الى المهجع، تحسّين وكأنهم كانوا في الساعة الماضية في قفص وحوش جائعة، ولم يكونوا بين أربعة من رجال الأمن، أربعة يفترض أنهم بشر، وأنهم من أبناء بلدهم! على المقلب الآخر لم تتفوّق على بربرية النظام إلا بربرية "داعش" وأخواتها! من أين جاء هؤلاء! حتى في الكواكب الأخرى لا توجد كائنات في سوية وحشيتهم. لا أعرف كيف استطاع الأمريكان والإسرائيليون والسعوديون والقطريون والأتراك تصنيعهم! لا أعرف كيف للكائن البشري أن يتقولب بهذه الطريقة المريضة! في لحظة اليأس هذه من تحول الثورة العظيمة إلى كارثة لجأت إلى العمل على الجسد العاري. كأني أهرب إلى الجمال من الواقع البشع. على مدى سنتين قبلها كان الأمل في قلبي أكبر من كبير. ثم غار في جبّ عميق مع صعود الفاشية الدينية. لذلك تجدين النساء في رسومي تلك لا يستعرضن جمالهن. كن يتأملن. كأن مظهرهن الهادئ له وظيفة واحدة. التستر على ما يتحطم في الخارج كما يتحطم في داخلي ودواخلهن.
 - أنت شخص ساخر، ولاذع، رسمت الكاريكاتير منذ سنة ١٩٦٦، لماذا توقف ذلك أو كاد يتوقف؟
- هل تعرفين رسام كاريكاتير مهم واحد اليوم؟ أسألك؟ لن تجدي. السبب هو أنّ الكاريكاتير ابن الحرية، ابن حرية الصحافة، ابن الآمال الكبرى. في الخمسينيات والستينيات رأينا كوكبة من أروع الرساميين المصريين: البهجوري، حجازي، بهجت، جاهين، الليثي.. إلخ. كانت فترة صعود قومي. الواقع متخلف، لكن الآمال عريضة، تريد أن تقتحم السماء.
كنا نعتقد أننا سنتوحد كعرب، سنقبر التخلف والأمية، والمرض، والفقر... وإسرائيل أيضاً. في هذه اللحظة الفارقة ظهرت تلك الكوكبة البديعة. في السبعينيات، مع الحرب الأهلية اللبنانية، رأينا ناجي العلي كأنه حامل مشعل فلسطين وانتصار اليسار اللبناني على الفاشية الموالية لإسرائيل. لو جاء اليوم ناجي العلي لما وجد جريدة عربية واحدة تنشر رسومه. الكاريكاتور ابن المعارك الكبرى والآمال الكبرى. من أين يأتي الكاريكاتير الحقيقي اليوم والزعماء العرب يحجون كالخراف الذليلة إلى واشنطن! والأجيال العربية في وهدة اليأس!
اليوم لدينا عدد كبير من الرسامين المحترفين المهرة، لكن نفتقد الواقع الذي يفجر مواهب هؤلاء، ويفتح لهم صدر الصحافة الحرّة، ويصنع من كل واحد منهم عشرة جاهينات وعشرة ناجيات وعشرة بهجاتوسات. بدل أن تكون الصحافة صوت الناس وسلطتهم أصبحت عدوّة الحرية وعدوة الشعوب العربية. أصبح النفط سيد الصحافة. وأصبح الدولار السعودي هو رئيس تحرير أغلب الصحف العربية. هل تعرفين صحيفة عربية واحدة تنتقد سياسات العربية السعودية مثلاً!
- أنت شخص ساخر، ولاذع، رسمت الكاريكاتير منذ سنة ١٩٦٦، لماذا توقف ذلك أو كاد يتوقف؟
- هل تعرفين رسام كاريكاتير مهم واحد اليوم؟ أسألك؟ لن تجدي. السبب هو أنّ الكاريكاتير ابن الحرية، ابن حرية الصحافة، ابن الآمال الكبرى. في الخمسينيات والستينيات رأينا كوكبة من أروع الرساميين المصريين: البهجوري، حجازي، بهجت، جاهين، الليثي.. إلخ. كانت فترة صعود قومي. الواقع متخلف، لكن الآمال عريضة، تريد أن تقتحم السماء.
كنا نعتقد أننا سنتوحد كعرب، سنقبر التخلف والأمية، والمرض، والفقر... وإسرائيل أيضاً. في هذه اللحظة الفارقة ظهرت تلك الكوكبة البديعة. في السبعينيات، مع الحرب الأهلية اللبنانية، رأينا ناجي العلي كأنه حامل مشعل فلسطين وانتصار اليسار اللبناني على الفاشية الموالية لإسرائيل. لو جاء اليوم ناجي العلي لما وجد جريدة عربية واحدة تنشر رسومه. الكاريكاتور ابن المعارك الكبرى والآمال الكبرى. من أين يأتي الكاريكاتير الحقيقي اليوم والزعماء العرب يحجون كالخراف الذليلة إلى واشنطن! والأجيال العربية في وهدة اليأس!
اليوم لدينا عدد كبير من الرسامين المحترفين المهرة، لكن نفتقد الواقع الذي يفجر مواهب هؤلاء، ويفتح لهم صدر الصحافة الحرّة، ويصنع من كل واحد منهم عشرة جاهينات وعشرة ناجيات وعشرة بهجاتوسات. بدل أن تكون الصحافة صوت الناس وسلطتهم أصبحت عدوّة الحرية وعدوة الشعوب العربية. أصبح النفط سيد الصحافة. وأصبح الدولار السعودي هو رئيس تحرير أغلب الصحف العربية. هل تعرفين صحيفة عربية واحدة تنتقد سياسات العربية السعودية مثلاً!
الكاريكاتور استطاع في شبابي أن يُنجيني من ذلّ سؤال السلطات أو المؤسسات للذهاب إلى الخارج في منحة دراسية!رسمت الكاريكاتير في يوم من الأيام وأنا مراهق نكاية بوالدي المنغمس في عالم السياسة حتى أعلى شعرة من رأسه. كان يعتقد أنّ الفن "منيح" لكن الكاريكاتور شيء "أهم". أردت تحديه، فتورطت في الكاريكاتور كل عمري. شاهد والدي في أحد الأيام رسماً لي عن حرب فيتنام. فقال لي بحسه النقدي الدائم: الفكرة جيدة، ولكن حجم جونسون (الرئيس الأميركي وقتذاك) صغير. فعارضته: إن حجمه يتناسب مع حجم الغابة بجانبه. وفي غمرة المماحكة قال: لن تجد في الدنيا كلها جريدة واحدة تنشر رسماً كهذا. وقتها لم أكن أفكر مطلقاً بالنشر. كنت مراهقاً في السادسة عشر من العمر. أرسلت الرسم بالبريد الى جريدة "إلى الأمام" الأسبوعية في بيروت، كان نسيب نمر الشيوعي اللبناني المخضرم والمنشق هو صاحبها ورئيس تحريرها، ولأن والدي كان مدير الجريدة في دمشق، ومنعاً لأيّ محاباة، أرسلت الرسم باسم آخر. نُشِر الرسم في الأسبوع بعد التالي فأحسست أني انتصرت في معركة واترلو. المفاجىء أن نسيب نمر بعد أن عرف اسم الرسام الحقيقي طلب مني تزويده برسم جديد كل أسبوع! والطريف أني نظرت الى والدي بعدها مناكفاً: أترى، هناك جريدة في العالم نشرت الرسم، وأي جريدة، جريدتك. فقال لي: بالرغم من ذلك.. جونسون صغير. يباسة الرأس وراثية. أشكره. أشكر والدي من كل جوارحي، لأنه دفعني من دون أن يدري في هذا الدرب، لأن الكاريكاتور استطاع في شبابي أن يُنجيني من ذلّ سؤال السلطات أو المؤسسات للذهاب إلى الخارج في منحة دراسية! واستطعت بفضله أن أعيش في أوربا متفرغاً لفني، لأنّ عمل بضع ساعات في الأسبوع كانت تكفيني للعيش. اليوم لا أرسم أكثر من رسم أو اثنين في الشهر. وأحتفظ في دفاتري بمئات الأفكار الكاريكاتورية لعلّ يوماً ما يأتي يفرج عني وعن تلك المشاريع فأحققها. على أي حال لدي أمل قليل في أن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحياة. سيكون حظي رائعاً لو كان في جهنم صحافة.
 - لا تزال متقشفاً تستخدم الأبيض والأسود وحدهما. لماذا؟ هل الأسباب فنية أم لها علاقة بالوضع خارج اللوحة؟ هل يمكن أن نرى لك مستقبلاً لوحات بالألوان؟
- لقد تحدثت أكثر من مرة حول خيار الأبيض والأسود، وعن أن التشكيليين ينقسمون إلى فئتين عريضتين: الرسامون والملونون. وهما تركيبان مختلفان تقنياً ونفسياً حيث يعمل الأولون على الخط والمساحة السوداء وبأدوات صلبة، ويعمل الآخرون على تناغمات الألوان الحارة والباردة وتناقضاتها وبأدوات طرية كالفرشاة. غنيٌّ عن القول أن التيارين مفتوحين واحدهما على الآخر تماماً، فآلاف الرسامين عملوا بالألوان وآلاف الملونين عملوا بالأبيض والأسود. غير أن التحكّم والجمال لدى كل تشكيلي يظهر أكثر ما يظهر عندما يعمل في حقله هو. بناءً عليه، أنا أرسم بالأبيض والأسود لاعتقادي أني أستطيع أن أحقق بهما نتائج أفضل. وبعبارة أخرى لا علاقة لذلك بأي تقشف أو أي معانٍ مأساوية للون الأسود.
الفنانون عموماً ينقسمون الى فئتين عريضتين بالنسبة لواحدية عملهم أو إلى تعدادها. هناك من يعمل على أسلوبه وموضوعه وتقنيته الواحدة عمره كله تقريباً، مثلما كان حال جياكوميتي أو فاتح المدرس. وهناك من نوّع أسلوباً وموضوعاً وتقنية أمثال بيكاسو وجواد سليم وصليبا الدويهي ونذير نبعة. الأخير، مثلاً، عمل في الستينيات على الأساطير بتقنية واقعية ثم تحوّل الى أشخاصه المبسّطة ذات اللون الأصفر الصحراوي، ثم عمل خلال دراسته في فرنسا على التجريد المستوحى من الأشكال النباتية، ثم قبل التجريد وبعده عمل على الموضوعات الشرقية في السبعينيات والثمانينيات، وختم العشرين سنة الأخيرة من حياته بالتجريد المستمد من تموضعات الصخور في الجبال... هذا إضافة الى أعمال الحبر الصيني بلمساته المسحوبة بالأصبع، وإضافة أيضاً إلى أغلفة الكتب والملصقات ورسوم كتب الأطفال، مسيرة غنية غنىً بديعاً. أعتقد أن تعقيدات العواطف والأفكار أولاً، والانتقال من الشباب الى الرجولة الى الشيخوخة ثانياً، وتنوع الحياة السياسية والاجتماعية وتقلباتها حولنا ثالثاً، يدفعنا أكثر الى طرح الأسئلة الجديدة، وابتكار المواضيع والأشكال الجديدة غير المألوفة أو غير المطروقة على الأقل بالنسبة إلى الفنان نفسه. هكذا يصبح تنوع عمل الفنان جزءًا أساسياً من اسئلته وشكّه على مدار الحياة.
رغم انغماسي بالرسم منذ خمسين عاماً فأنا كثيراً ما أفكر بوسائط أخرى، مثل النحت أو الخزف والألوان. أنجزتُ مثلاً في السنوات العشر الماضية ما يقارب من مئتي قطعة خزف، غير أني أعتبر نفسي هاوياً يتعرف على المواد ليس غير.
كما عملت مجموعة "أشخاص" بين عامي ١٩٨٩–١٩٩٥ وهي بالألوان الترابية وألوان الباستيل، غير أني أعتقد أن بنيتها غرافيكية على عكس ما يوحي للوهلة الأولى مظهرها.
الأبيض والأسود ملعبي، لكن المجالات الأخرى أراها دائماً مغرية، بغض النظر عن أنها ستكون مساراً آخراً أو نزوةً عابرة.
- لا تزال متقشفاً تستخدم الأبيض والأسود وحدهما. لماذا؟ هل الأسباب فنية أم لها علاقة بالوضع خارج اللوحة؟ هل يمكن أن نرى لك مستقبلاً لوحات بالألوان؟
- لقد تحدثت أكثر من مرة حول خيار الأبيض والأسود، وعن أن التشكيليين ينقسمون إلى فئتين عريضتين: الرسامون والملونون. وهما تركيبان مختلفان تقنياً ونفسياً حيث يعمل الأولون على الخط والمساحة السوداء وبأدوات صلبة، ويعمل الآخرون على تناغمات الألوان الحارة والباردة وتناقضاتها وبأدوات طرية كالفرشاة. غنيٌّ عن القول أن التيارين مفتوحين واحدهما على الآخر تماماً، فآلاف الرسامين عملوا بالألوان وآلاف الملونين عملوا بالأبيض والأسود. غير أن التحكّم والجمال لدى كل تشكيلي يظهر أكثر ما يظهر عندما يعمل في حقله هو. بناءً عليه، أنا أرسم بالأبيض والأسود لاعتقادي أني أستطيع أن أحقق بهما نتائج أفضل. وبعبارة أخرى لا علاقة لذلك بأي تقشف أو أي معانٍ مأساوية للون الأسود.
الفنانون عموماً ينقسمون الى فئتين عريضتين بالنسبة لواحدية عملهم أو إلى تعدادها. هناك من يعمل على أسلوبه وموضوعه وتقنيته الواحدة عمره كله تقريباً، مثلما كان حال جياكوميتي أو فاتح المدرس. وهناك من نوّع أسلوباً وموضوعاً وتقنية أمثال بيكاسو وجواد سليم وصليبا الدويهي ونذير نبعة. الأخير، مثلاً، عمل في الستينيات على الأساطير بتقنية واقعية ثم تحوّل الى أشخاصه المبسّطة ذات اللون الأصفر الصحراوي، ثم عمل خلال دراسته في فرنسا على التجريد المستوحى من الأشكال النباتية، ثم قبل التجريد وبعده عمل على الموضوعات الشرقية في السبعينيات والثمانينيات، وختم العشرين سنة الأخيرة من حياته بالتجريد المستمد من تموضعات الصخور في الجبال... هذا إضافة الى أعمال الحبر الصيني بلمساته المسحوبة بالأصبع، وإضافة أيضاً إلى أغلفة الكتب والملصقات ورسوم كتب الأطفال، مسيرة غنية غنىً بديعاً. أعتقد أن تعقيدات العواطف والأفكار أولاً، والانتقال من الشباب الى الرجولة الى الشيخوخة ثانياً، وتنوع الحياة السياسية والاجتماعية وتقلباتها حولنا ثالثاً، يدفعنا أكثر الى طرح الأسئلة الجديدة، وابتكار المواضيع والأشكال الجديدة غير المألوفة أو غير المطروقة على الأقل بالنسبة إلى الفنان نفسه. هكذا يصبح تنوع عمل الفنان جزءًا أساسياً من اسئلته وشكّه على مدار الحياة.
رغم انغماسي بالرسم منذ خمسين عاماً فأنا كثيراً ما أفكر بوسائط أخرى، مثل النحت أو الخزف والألوان. أنجزتُ مثلاً في السنوات العشر الماضية ما يقارب من مئتي قطعة خزف، غير أني أعتبر نفسي هاوياً يتعرف على المواد ليس غير.
كما عملت مجموعة "أشخاص" بين عامي ١٩٨٩–١٩٩٥ وهي بالألوان الترابية وألوان الباستيل، غير أني أعتقد أن بنيتها غرافيكية على عكس ما يوحي للوهلة الأولى مظهرها.
الأبيض والأسود ملعبي، لكن المجالات الأخرى أراها دائماً مغرية، بغض النظر عن أنها ستكون مساراً آخراً أو نزوةً عابرة.
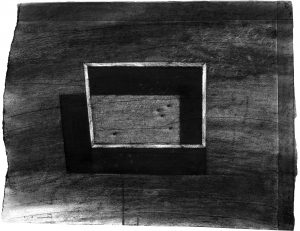 - يوسف، أنت تبدو كمن أُطعِمَ الحج والناس راجعة. تعود إلى دمشق وتبقى فيها في الوقت ذاته الذي وجد معارضون، ومنهم رفاق لك سابقون، أنّ ما انطلق في سوريا 2011 فرصة للخروج منها. وبلغت قناعتهم في ذلك حد تجريم من بقوا واتهامهم. ما الذي يبقيك في دمشق على الرغم من المخاطر التي أحاقت وتحيق بك؟
- أصبحت مسألة المعارضة في الداخل والخارج مسألة تستحق التوقف طويلاً. وأصبحت حملات المعارضين في الخارج ضد المعارضين في الداخل ظاهرة تخرج عن كونها فعلاً فردياً. وأحد أسباب ذلك أن الكتابة على "فيسبوك" ليس لها من ضابط يضبطها إلا حكمة الشخص وأخلاقه! وهذه ليست متساوية لدى البشر لا في الداخل ولا في الخارج.
الأمر الثاني الأهم هو بعدها النفسي–السياسي. معارض الداخل يثير الحنق، لأن مجرد وجوده في الداخل يشكل تحدياً لمعارض الخارج وينزع منه مبررات خروجه. ولا سبيل للرد على ذلك الحنق المبرر إلا رمي معارضي الداخل بشتى التهم.
تبلغ الشتائم في بعض الأحيان درجة لا أخلاقية! كأن معارضي الداخل هم الذين كانوا يرمون حلب بالبراميل المتفجرة! وحدوا اللّه! وتبلغ أحياناً درجة مضحكة. أحد المعماريين الممسوسين في الخارج والذي عاش أربعين عاماً في الداخل كالأرنب، يشتمني على الطالع والنازل مستحضراً المعمارية العظيمة زها حديد. لا أعرف إن كان صاحبنا متحاملاً أم مختلّاً، فهو ينسى أن زها حديد معماريّة عظيمة لأنها أنجزت تسعمائة وخمسين مشروعاً معمارياً جديداً، وليس لأنها استمرأت عطالتها وجلست وراء كمبيوترها وراحت تشتم على "فيسبوك" من يعملون. هكذا تصبح للثرثرة واستسهال شتم الآخرين وظيفة: مشجب نعلق عليه عطالتنا وخوائنا المهني.
يخطر ببال المعارضين في الداخل أن يسألوا أولئك دائماً: إذا كنا مقصّرين فتعالوا وأنجزوا أفضل منّا. غير أن الرد جاهز: لدينا ظروف أمنية! طيب.. هذا صحيح، ولكن هل المعارضون في الداخل يعيشون في سويسرا! هم واقعون تحت نفس الضغوط التي تهربون منها! رغم كل ذلك أنا أتعاطف مع المعارضين "الفيسبوكيين" في الخارج لأنهم ضحايا النظام. لذلك هم معذورون عندما يخطئون في التحليل أو في الحكم على من هم في الداخل. سبق أن عانيت ظروف الغربة لمدة أربعة وعشرين عاماً. أعرف ما معنى أن تكون مقتلعاً من بلدك بالقوة. آمل أن تسكّن قلوبهم الحكمة يوماً ويرون الكارثة التي تنهكنا جميعاً في الداخل والخارج؟!
- يوسف، أنت تبدو كمن أُطعِمَ الحج والناس راجعة. تعود إلى دمشق وتبقى فيها في الوقت ذاته الذي وجد معارضون، ومنهم رفاق لك سابقون، أنّ ما انطلق في سوريا 2011 فرصة للخروج منها. وبلغت قناعتهم في ذلك حد تجريم من بقوا واتهامهم. ما الذي يبقيك في دمشق على الرغم من المخاطر التي أحاقت وتحيق بك؟
- أصبحت مسألة المعارضة في الداخل والخارج مسألة تستحق التوقف طويلاً. وأصبحت حملات المعارضين في الخارج ضد المعارضين في الداخل ظاهرة تخرج عن كونها فعلاً فردياً. وأحد أسباب ذلك أن الكتابة على "فيسبوك" ليس لها من ضابط يضبطها إلا حكمة الشخص وأخلاقه! وهذه ليست متساوية لدى البشر لا في الداخل ولا في الخارج.
الأمر الثاني الأهم هو بعدها النفسي–السياسي. معارض الداخل يثير الحنق، لأن مجرد وجوده في الداخل يشكل تحدياً لمعارض الخارج وينزع منه مبررات خروجه. ولا سبيل للرد على ذلك الحنق المبرر إلا رمي معارضي الداخل بشتى التهم.
تبلغ الشتائم في بعض الأحيان درجة لا أخلاقية! كأن معارضي الداخل هم الذين كانوا يرمون حلب بالبراميل المتفجرة! وحدوا اللّه! وتبلغ أحياناً درجة مضحكة. أحد المعماريين الممسوسين في الخارج والذي عاش أربعين عاماً في الداخل كالأرنب، يشتمني على الطالع والنازل مستحضراً المعمارية العظيمة زها حديد. لا أعرف إن كان صاحبنا متحاملاً أم مختلّاً، فهو ينسى أن زها حديد معماريّة عظيمة لأنها أنجزت تسعمائة وخمسين مشروعاً معمارياً جديداً، وليس لأنها استمرأت عطالتها وجلست وراء كمبيوترها وراحت تشتم على "فيسبوك" من يعملون. هكذا تصبح للثرثرة واستسهال شتم الآخرين وظيفة: مشجب نعلق عليه عطالتنا وخوائنا المهني.
يخطر ببال المعارضين في الداخل أن يسألوا أولئك دائماً: إذا كنا مقصّرين فتعالوا وأنجزوا أفضل منّا. غير أن الرد جاهز: لدينا ظروف أمنية! طيب.. هذا صحيح، ولكن هل المعارضون في الداخل يعيشون في سويسرا! هم واقعون تحت نفس الضغوط التي تهربون منها! رغم كل ذلك أنا أتعاطف مع المعارضين "الفيسبوكيين" في الخارج لأنهم ضحايا النظام. لذلك هم معذورون عندما يخطئون في التحليل أو في الحكم على من هم في الداخل. سبق أن عانيت ظروف الغربة لمدة أربعة وعشرين عاماً. أعرف ما معنى أن تكون مقتلعاً من بلدك بالقوة. آمل أن تسكّن قلوبهم الحكمة يوماً ويرون الكارثة التي تنهكنا جميعاً في الداخل والخارج؟!
 - تبدو عكس التيار و"دقّة قديمة" حتى فكرياً وسياسياً وأيديولوجياً. يا رجل، كيف يمكن لفنان من وزنك أن يكون متحزّباً إلى هذا الحدّ؟ وكيف يمكن لرهاناته أن تبقى عند "الكادحين" بعيداً عن الإعجاب بالعالم الحرّ الذي راح رفاق لك كثيرون يتغنون به ويتوسّلون إنقاذه؟
- يحتاج هذا السؤال إلى مجلد للإجابة عنه. لتعدد مستوياته، وإمكانات الاستفاضة في التحليل في كل مستوى. في البداية أود القول إني أكاد لا أعرف أي كاتب أو شاعر أو رسام إلا وكان متحزباً، أو كان متحزباً في يوم ما، في بلادنا وفي العالم، من كبار شعراء العربية إلى أهم أسماء التشكيليين، من درويش وأدونيس ومنيف والفيتوري وجلال خوري وونوس إلى مروان ومدرس ونبعه ورمسيس يونان وحامد عويس... إلخ. ربما يظن بعض المثقفين أن الإعلان عن الانتماء السياسي يضيّق مجال تأثيرهم، بينما وظيفة المثقف أن يخاطب الجمهور الواسع. أعتقد أن في الأمر لبسًا ما؛ وهو الخلط بين الانتماء السياسي والعمل الفني أو الأدبي. العمل السياسي يومي، تفاصيلي، بينما حقل العمل الفني وهدفه العالم كله والبشر أجمعين، وعلى مدى زمني طويل. على الإنتاج الثقافي أن يرى أوسع من هموم السياسة اليومية، وهذا هو التحدي: انتمى درويش الى الحزب الشيوعي ولكن شعره كان ضمير فلسطين ومقاومة شعبها، ورأى فيه العرب صورة مأزقهم وقوة أحلامهم.
ثم إنَّ انتمائي، في معناه العريض، هو احتجاج على الظلم، بحث عن العدالة، وعن شيء من الحرية، وعن شيء من العقلانية في السياسة. وبصراحة، لا أجد في ذلك ما يضيرني أو ما أتهرّب منه!
أما التغني بالعالم الحر الذي صنع على مدى القرون الثلاثة الماضية بعرق ودم ملايين العمال والفلاحين في أوروبا وأمريكا، ثم من استعمار ثلاثة أرباع شعوب الكرة الأرضية، وثم من نهب ثروات شعوب العالم وإفقارها وإذلالها.. فهذا العالم الحر، رغم كل تقدمه التقني والصناعي والإداري والثقافي، لا يسعدني قطّ أن أتغنى به وبمفاخره الوحشية. هو نفس العالم الحر الذي دمر العراق ونهبه وفتته منذ ١٧ عاماً، ودمر ويدمر ليبيا وسوريا واليمن اليوم. لو كان الغرب صانعاً للحرية والديمقراطية لوقفت إلى جانبه كل شعوب الأرض. الاتكال على الغرب لا يعكس إلا تغييبنا لعقلنا أولاً، وطمساً للوقائع المفجعة حولنا ثانياً، وثالثاً يعكس يأسنا من إمكانات التغيير بيد شعبنا نفسه. ليس جديداً أنّ كثيراً من النخب قصيرة النفس. وهي تغطي ذلك برطانة سياسية وفكرية لا تقنع حتى الرضّع!
على المقلب الآخر، تجد العالم الثالث وأنظمته الديكتاتورية التابعة للغرب والتي لا تنفق المليارات على شراء الأسلحة إلا لاستخدامها ضد شعوبها نفسها (وليس ضد أي عدو خارجي)! ذلك أن وظيفة السلاح هي حماية الاستغلال والنهب المنظم والفساد.
طالما العدالة غائبة عن هذا العالم فشرف الإنسان أن يكون في صف البشر، في صفّ الأُجراء المقهورين الباحثين عن لقمة الخبز، ولقمة الحرية، ولقمة الكرامة.
طالما أن هناك ٢٦ غنياً فقط يملكون أكثر من ٥٠٪ مما يملكه كل فقراء العالم، فالعدالة ستبقى هاجساً للبشرية.
- تبدو عكس التيار و"دقّة قديمة" حتى فكرياً وسياسياً وأيديولوجياً. يا رجل، كيف يمكن لفنان من وزنك أن يكون متحزّباً إلى هذا الحدّ؟ وكيف يمكن لرهاناته أن تبقى عند "الكادحين" بعيداً عن الإعجاب بالعالم الحرّ الذي راح رفاق لك كثيرون يتغنون به ويتوسّلون إنقاذه؟
- يحتاج هذا السؤال إلى مجلد للإجابة عنه. لتعدد مستوياته، وإمكانات الاستفاضة في التحليل في كل مستوى. في البداية أود القول إني أكاد لا أعرف أي كاتب أو شاعر أو رسام إلا وكان متحزباً، أو كان متحزباً في يوم ما، في بلادنا وفي العالم، من كبار شعراء العربية إلى أهم أسماء التشكيليين، من درويش وأدونيس ومنيف والفيتوري وجلال خوري وونوس إلى مروان ومدرس ونبعه ورمسيس يونان وحامد عويس... إلخ. ربما يظن بعض المثقفين أن الإعلان عن الانتماء السياسي يضيّق مجال تأثيرهم، بينما وظيفة المثقف أن يخاطب الجمهور الواسع. أعتقد أن في الأمر لبسًا ما؛ وهو الخلط بين الانتماء السياسي والعمل الفني أو الأدبي. العمل السياسي يومي، تفاصيلي، بينما حقل العمل الفني وهدفه العالم كله والبشر أجمعين، وعلى مدى زمني طويل. على الإنتاج الثقافي أن يرى أوسع من هموم السياسة اليومية، وهذا هو التحدي: انتمى درويش الى الحزب الشيوعي ولكن شعره كان ضمير فلسطين ومقاومة شعبها، ورأى فيه العرب صورة مأزقهم وقوة أحلامهم.
ثم إنَّ انتمائي، في معناه العريض، هو احتجاج على الظلم، بحث عن العدالة، وعن شيء من الحرية، وعن شيء من العقلانية في السياسة. وبصراحة، لا أجد في ذلك ما يضيرني أو ما أتهرّب منه!
أما التغني بالعالم الحر الذي صنع على مدى القرون الثلاثة الماضية بعرق ودم ملايين العمال والفلاحين في أوروبا وأمريكا، ثم من استعمار ثلاثة أرباع شعوب الكرة الأرضية، وثم من نهب ثروات شعوب العالم وإفقارها وإذلالها.. فهذا العالم الحر، رغم كل تقدمه التقني والصناعي والإداري والثقافي، لا يسعدني قطّ أن أتغنى به وبمفاخره الوحشية. هو نفس العالم الحر الذي دمر العراق ونهبه وفتته منذ ١٧ عاماً، ودمر ويدمر ليبيا وسوريا واليمن اليوم. لو كان الغرب صانعاً للحرية والديمقراطية لوقفت إلى جانبه كل شعوب الأرض. الاتكال على الغرب لا يعكس إلا تغييبنا لعقلنا أولاً، وطمساً للوقائع المفجعة حولنا ثانياً، وثالثاً يعكس يأسنا من إمكانات التغيير بيد شعبنا نفسه. ليس جديداً أنّ كثيراً من النخب قصيرة النفس. وهي تغطي ذلك برطانة سياسية وفكرية لا تقنع حتى الرضّع!
على المقلب الآخر، تجد العالم الثالث وأنظمته الديكتاتورية التابعة للغرب والتي لا تنفق المليارات على شراء الأسلحة إلا لاستخدامها ضد شعوبها نفسها (وليس ضد أي عدو خارجي)! ذلك أن وظيفة السلاح هي حماية الاستغلال والنهب المنظم والفساد.
طالما العدالة غائبة عن هذا العالم فشرف الإنسان أن يكون في صف البشر، في صفّ الأُجراء المقهورين الباحثين عن لقمة الخبز، ولقمة الحرية، ولقمة الكرامة.
طالما أن هناك ٢٦ غنياً فقط يملكون أكثر من ٥٠٪ مما يملكه كل فقراء العالم، فالعدالة ستبقى هاجساً للبشرية. 